قراءة في مسيرة الفنان ادريس العمارتي: رجل ظلّ، يعمل في الهامش ليضيء المركز، وفيا للمسرح مؤمنا بدوره في التربية والاحتجاج والتطهير.


وُلد إدريس العمارتي سنة 1953 في حومة سقاية الدمناتي، زقاق الرمان، في قلب مدينة فاس العتيقة، حيث كانت الأزقة تضيق بالذاكرة كما تضيق بالناس، لكنها تتسع للجميع، وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت أسرته تقيم مع أسرة عبد العزيز الحريشي، التاجر المعروف، وزوجته للافاطمة السبتية، المنحدرة من أسرة فاسية عريقة متميزة بالتواضع والكرم وحسن الجوار، بين الأسرتين نشأت علاقة إنسانية استثنائية، قوامها الاحترام والتكافل والمشاركة اليومية في تفاصيل الحياة، كان والد إدريس يملك فرنًا بلديًا في درب قتانة، ورثه عن أبيه كما تُورث الحِرَف المتجذّرة، وكان معروفًا في الحومة بصفاء سريرته، يخدم الناس قبل نفسه، يلاطف الصغار ويعين المحتاجين، ويكون حاضرًا لكل سرٍّ يُستودَع عنده، حتى غدا “العلبة السوداء” للحي، ولم يكن إدريس سوى الابن البكر الذي كُتب له أن يحمل مبكرًا بعضًا من مسؤوليات البيت بعد رحيل أخيه الأول، سعيد، الذي توفي في عامه الثاني، هذا الفقد جعله أقرب إلى والده، يتعلّم منه المهنة وطبائع الناس، ويقاسمه العمل في الفرن منذ طفولته، فيُعدّ الخبز والحلويات حين يكون الوالد منشغلًا بشؤون أخرى، ومن الذكريات التي شكّلت وعيه المبكر تلك الرحلات الليلية خارج أسوار مدينة فاس، وهو لا يزال طفلًا، على ظهر البغال رفقة والده وبعض المستخدمين، من بينهم مصطفى، القادم من مدينة مولاي إدريس زرهون، والذي استقدمه جدّ إدريس من أبواب الحرم الإدريسي، كانت الرحلة تمتد نحو سفوح جبل زلاغ لجمع حطب “بيت النار” الذي يُخزَّن لفصل الشتاء في “الروى”، (إسطبل البغال والحمير)، وكان والد إدريس يملك عددًا من هذه الدواب والاسطبلات، غير أن معظمها ضاع في غمار نزوات الحياة وتقلباتها، هكذا نشأ إدريس بين حرارة الفرن والعلاقات الأسرية المتينة، وبرودة ليالي الشتاء، بين حكمة الأب وصلابة المهنة، وبين جيرانٍ يشبهون العائلة وعائلةٍ تتسع للجيران، كانت تلك البدايات هي التي صاغت شخصيته وفتحت له دروب الحياة الأولى.بدأ إدريس، في سنوات طفولته الأولى، يلتفت إلى الفروق الطبقية التي تفصل بين عالم أسرته البسيط وعالم أسرة الحاج عبد العزيز الحريشي التي عاش إلى جوارها طوال أواخر الخمسينيات وبدايات الستينيات، كان كل ما يحيط بالأسرة الجارة يبدو له نافذة على واقع مختلف تمامًا، سيارة مكشوفة، هاتف منزلي نادر في ذلك الزمن، بيانو يرطن بنغمات غريبة عليه، مكتبة عامرة بكتب ومجلات فرنسية، وحمام منزلي عصري لم تعهده البيوت التقليدية من حولهم، كانت هذه العناصر، في مجموعها، تكشف لطفلٍ لا يتجاوز بضع سنوات مسافة اجتماعية لم يفهمها نظريًا، لكنه كان يراها تتمثل أمامه كل يوم، كان إدريس يراقب هذا العالم من خلال وسائله البريئة، شباك النوافذ الستة المطلة على وسط الدار في الطابق السفلي، أو أثناء عبوره اليومي بين “السفلي “و”الفوقي”، أو حين ترسله أمه لقضاء مهمة لدى جيرانها، فيدخل البيت ويجد نفسه وسط جوٍّ مختلفٍ تمامًا في الانضباط والسكينة ودفء الحروف المتراصة على صفحات الكتب والمجلات، وفي المناسبات الاجتماعية التي تجمع الأسرتين، كان يزداد إدراكه لثراء عالمهم الرمزي قبل المادي، وجوه هادئة، بشاشة لا تفارق الملامح، أسلوب كلام راقٍ، وسلوكيات توحي بتربية منظمة، كما كان يتتبع، بوعي طفلٍ يتشكّل، حركة أبناء الأسرة الذين بدأ بعضهم يهاجر إلى ألمانيا وفرنسا والسنغال، فيتسع أمامه مفهوم العالم وامتداداته، ولعل أكثر ما ترك فيه أثرًا عميقًا هو تلك المكتبة الكبيرة التي كانت عامرة بالكتب والمجلات الفرنسية، والتي كان يراها تُقرأ بشكل يومي، لا كزينة منزلية، وإنما كعادة راسخة، من ذلك الفضاء بالذات بدأ وعيه بالقراءة يتكوّن؛ إذ التقط، دون أن يدري، فكرة أن للمعرفة طقسًا يوميًا، وأن للقراءة رائحة خاصة تملأ البيت وتهذب العقول، هكذا، دون تنظير أو تعليم مباشر، بدأت تتشكل لدى إدريس حساسية اجتماعية مبكرة، تدرك الفوارق الاجتماعية بحس فيه الكثير من الغبطة، وتلاحظ الامتياز دون رغبة في تقليده بشكل أعمى، كانت تلك التجربة الأولى التي جعلته يرى أن المجتمع طبقات، وأن الإنسان يمكن أن يتعلم عبر الاحتكاك اليومي بالناس والبحث في سطور الكتب عن العلم والمعرفة، لقد كان عالم الحريشي مدرسة غير معلنة، صقلت نظرته إلى المعرفة وإلى الفوارق وإلى المستقبل الذي كان يتكون بصمت داخل طفل يتأمل من وراء النافذة.

عندما بلغ إدريس سن الرابعة، قرر والده أن يبدأ له طريق التعلم، فأدخله إلى دار الفقيهة للا الباتول الشرقاوية، أخت محمد الشرقاوي صاحب دكان البقالة الملاصق لدار الضمانة، تحت ظلال شجرة التوت الهرمة التي كانت تشهد يوميًا حركة الناس وهمومهم، كان محمد الشرقاوي شخصية لا تُنسى، فقد كان يتقن تقليد الممثل المصري إسماعيل ياسين بمهارة تثير الضحك، يحمل عصا “الشطابة” (المكنسة) على كتفه ويرقص داخل الدكان، يغني ويتقمص الشخصية إلى حدِّ أنه ينسى الزبائن العجلى الذين ينتظرون منه بضاعة، لتتحول البقالة إلى مسرح صغير يتقاطع فيه الهزل مع تفاصيل الحياة اليومية، بعد فترة في دار الفقيهة، انتقل إدريس إلى الكتاب عند الفقيه السي المكي، في نقطة التقاء حي الشرابليين وحي الطرافين.، هناك كان الانضباط سيد الموقف، وكان السي المكي يعتمد على “المحضرية” لضبط المشاغبين، وعلى رأسهم أكبرهم، وكان اسمه أيضًا إدريس، وعندما يغيب الفقيه، كان إدريس ينوب عنه، وفي بعض الأحيان كان صاحبنا يُكلّف بدور المراقب الصغير، في ذلك الجو، تمكن من حفظ عدد من السور القرآنية مثل الملك والرحمن، وكان إذا خلا بنفسه في غرفته يحاول تقليد صوت الشيخ المقرئ عبد الباسط عبد الصمد، واضعًا راحتيه على أذنيه، مسافرًا بصوته نحو سماوات الإعجاب والدهشة، انتقل بعدها إلى المدرسة الأميرية الواقعة تحت مسجد جامع الحمرا، وكانت المدرسة تخضع لوصاية أحد الشرفاء الوزانيين، درّسه في اللغة العربية الأخ الأكبر للمطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي ( اسمه الحقيقي المعطي بوكرن)، وكان صارمًا في تلقين فن الخط العربي؛ إذ كان يُلزم التلاميذ بكتابة التاريخ الهجري بلون، والميلادي بلون آخر، مما أكسبه حسًّا بصريًا وتنظيميًا بقي ملازمًا له طوال حياته، بعد ذلك سجله والده في مدرسة اللمطيين بدرب العامر، أي الشريف الإدريسي، والتي تحمل اليوم اسم عبد الرحيم بوعبيد، وما يزال إدريس يتذكر رحابة ساحاتها، ونظافة مرافقها، ووجبة “كونتيل الكومير والحليب ودقيق السمك” التي كان يناولها لهم الحارس عبد الكريم بابتسامة رقيقة، كان للهيئة البهية للمعلمين والمعلمات أثر عميق في نفسه، أناقتهم، طريقتهم في الوقوف والشرح، حضورهم القوي، خصوصًا معلمة الفرنسية مدام غنيم التي كان يحمل لها دفاتر القسم من درب العامر إلى البطحاء لتصحيحها، وهو يشعر بزهو طفلٍ يؤدي مهمة نبيلة، ويتذكر المدير السي بنجبور بهيبته وجلبابه الطويل، وكيف كان يختلس “التنفيحة” داخل مكتبه بعيدًا عن أعين التلاميذ، كما يذكر المعلم السي السلاسي، ذو الأصول الجبلية، الذي كان يُنزل عقوبات صارمة “سلخات” على من لا يحفظ دروسه، مستعينًا بتلميذين قويي البنية، أما السي أكومي، فكان شكله وجلبابه وطربوشه المشقوق يذكّرانه بالسلطان محمد الخامس، ومن أكثر الشخصيات رسوخًا في ذاكرته كان المعلم السي الكروالي، الذي لعب دورًا مهمًا في تشكيل طلاقته اللفظية وحسن مخارج الحروف، فكان يدربه ومعه التلاميذ على نطق القاف والراء نطقًا سليمًا، وهي الملكة التي ستلازمه لاحقًا في القراءة والإلقاء المسرحي.

ورغم أنه كان يقضي ساعات يومه بين هذه الوجوه، إلا أن إدريس ظل في المدرسة الابتدائية طفلًا منطويًا على نفسه، يميل إلى الهدوء داخل القسم، لكنه ما إن يخرج إلى فضاء العرصة (كان عبارة عن ساحة تلعب فيها مباريات كرة القدم بدون تجهيزات) حتى يتحول إلى طفل آخر، ينفّس عن صمته بلعب كرة القدم والجري خلف أطفال درب قتانة، بعضهم من المشاغبين الذين كانوا مُدرجين في “اللائحة السوداء”، كثيرًا ما عاد إلى البيت وجرحٌ يشق رجله أو يده، وأحيانًا برأسٍ “مفلوق” به شجة ، فتستقبله يد الأب بالعقاب، ليس قسوة، بل رغبة في تربيته وإعداده لمستقبل أفضل، لم يكن إدريس متفوقًا في الابتدائي، بل أعاد قسم “المتوسط الثاني”. وفي تلك الفترة زارت زوجة جدّه والدته، ولما علمت أن أحد أبناء الجيران نجح وصعد إلى الإعدادي فيما إدريس لم ينجح، قالت لها بلهجة مواسية، “لا تحزني آ للا الدريسية، حرفة بوه لا يغلبوه”، في إشارة إلى فرن والده والمطرح وبيت النار، ظل وقع هذه العبارة يثقل قلب والدته ويجرح قلب إدريس، أما والده فلم يسمع بها، ومع ذلك تركت في نفسه أثرًا دفعه أحيانًا إلى ترك الدراسة، وكاد يلتحق مبكرًا بالحياة العملية لولا تدخل خاله حميدو شعشوع، رحمه الله، الذي عاش معهم فترة قبل زواجه، وكان يدرك قيمة المدرسة لأنه حُرم منها مثل كثيرين من أبناء جيله الذين اضطروا لدخول سوق العمل مبكرًا، يتعلمون حرفة من الحرف التقليدية كي لا يكونوا عبئًا على أسرهم، في تلك المرحلة كان إدريس يساعد والده في الفرن كلما احتاجه، وتعلم شيئًا فشيئًا مهارة طهي الخبز والحلويات، خاصة في ليالي الأعياد ورمضان، حيث كان الفرن يتحول إلى ورشة دافئة يتداخل فيها نور النار مع رائحة الخبز والبهجة التي لا تخلو منها تلك الأمسيات، وهكذا، بين المدارس والكتاتيب، وبين سلطة الأب ونصائح الخال، وبين انطواء القسم وصخب الحومة، بدأت شخصية إدريس تتشكل، تحمل مزيجًا من الحساسية والخجل والمثابرة، ماضٍ صغير يمهد لحياة كبيرة قادمة.

بعد حصول إدريس على الشهادة الابتدائية، انتقل إلى إعدادية الزنجفور، وكان مديرها آنذاك السي الودغيري، يعاونه في التنظيم والانضباط كلٌّ من الحراس العامين العلوي الصوصي والغساسي، وفي هذا الفضاء التربوي تشكّلت أولى ملامح وعيه المعرفي والجمالي، إذ ترك بعض الأساتذة بصمات لا تمحى في ذاكرته، وعلى رأسهم أستاذ اللغة العربية السي السبتي، الذي درّسه في قسم الملاحظة رقم 14 (COB14). كان السبتي مثالاً للأناقة في المظهر والعمق في التعبير؛ يفرض حضوره بالبساطة والصرامة الهادئة، ويجعل من الدرس لحظة انتظار محبّبة لدى التلاميذ، كانت حصة المحفوظات، تحديدًا، من أحبّ الحصص إلى إدريس. كان السي السبتي يطلب من التلاميذ حفظ النصوص الشعرية وإلقاءها، لا على سبيل الواجب، بل كطقس تربوي يعيد للشعر هيبته وسحره، ويتذكر إدريس جيدًا تلك اللحظة التي أنشد فيها، مع مجموعة من زملائه، مقاطع من قصيدة الأمير المعتمد بن عباد، دفين أغمات، التي مطلعها:
فيما مضى كنتُ بالأعيادِ مسرورَا فجاءك العيدُ في أغماتَ مأسورَا
كان السبتي يصوّب مخارج الحروف، ويضبط الإيقاع والحركات، فيحوّل الإلقاء إلى درس في التذوق، لا مجرد ترديدٍ لنص محفوظ، وإلى جانب السي السبتي، برز في ذاكرته أستاذ آخر للغة العربية، هو الصوصي العلوي، الذي سيزوره إدريس بعد سنوات طويلة في بيته بحومة البليدة، بعد أن عين ادريس أستاذًا للغة العربية في الدار البيضاء، استقبله الأستاذ بحرارة، وفاجأه بأنه لا يزال يحتفظ بأوراق إنشائه القديمة، اعترافًا بتفوّق إدريس في التعبير الكتابي منذ تلك المرحلة المبكرة، في تلك السنوات نفسها بدأ شغف إدريس بالمسرح يتبلور. قبيل عيد العرش، بادرت إدارة الإعدادية إلى إعداد حفل تنشيطي، فاختارت مجموعة من التلاميذ للمشاركة، وكان إدريس بينهم، أمضوا ليلة كاملة داخل أحد الأقسام بالاعدادية في مهمة الحراسة والتدريب استعدادًا للحفل، حيث صعد إدريس الخشبة لأول مرة ليؤدي سكيتشًا بعنوان “الدار”، كان العرض في الساحة على شكل حلقة، لكن إدريس سرعان ما أمسك بخيوط اللعبة، يحركها ويسيّر الإيقاع بحضور لافت، من بين التلاميذ الذين شاركوا أو حضروا تلك الحلقة يتذكر الكاتب المسرحي عبد النعيم الزعيم، والخطاط الأستاذ محمد الفيلالي صبري، ورغم مرور الزمن، ما تزال كلمات السكيتش منقوشة في ذاكرة إدريس، كأنها نُظمت بالأمس:
“والدار داري
وأنا خليتها لجاري
هذا يشري وهذا يكري
هذا يهرّس وهذا يترس
هذه شرارة من ناري
هذي حكاية للدراري
والدار داري
وأنا خليتها لجاري“
ولا يزال إدريس، إلى اليوم، يتساءل عن الدافع الحقيقي وراء نظم تلك العبارات: أكانت “الدار” رمزًا للبيت العائلي، أم للوطن، أم لدار الدنيا نفسها؟”، ولإتمام دوره المسرحي في ذاك العرض، حمل إدريس من منزله جلبابًا صوفيًا لجده، وعكازًا نحته جدّه بيده من عيدان الأشجار في زلاغ، إضافة إلى مسبحته ورزّته، كانت تلك اللحظة الشرارة الأولى التي أوقدت فيه رغبة الغوص في عالم المسرح، خاصة بعدما رأى دهشة المتفرجين وإعجابهم بعرضه، فشعر أنّ الخشبة ليست مجرد فضاء للعب، وإنما مسرح لقول ما لا يُقال، وللإقامة في ما يشبه الحلم.
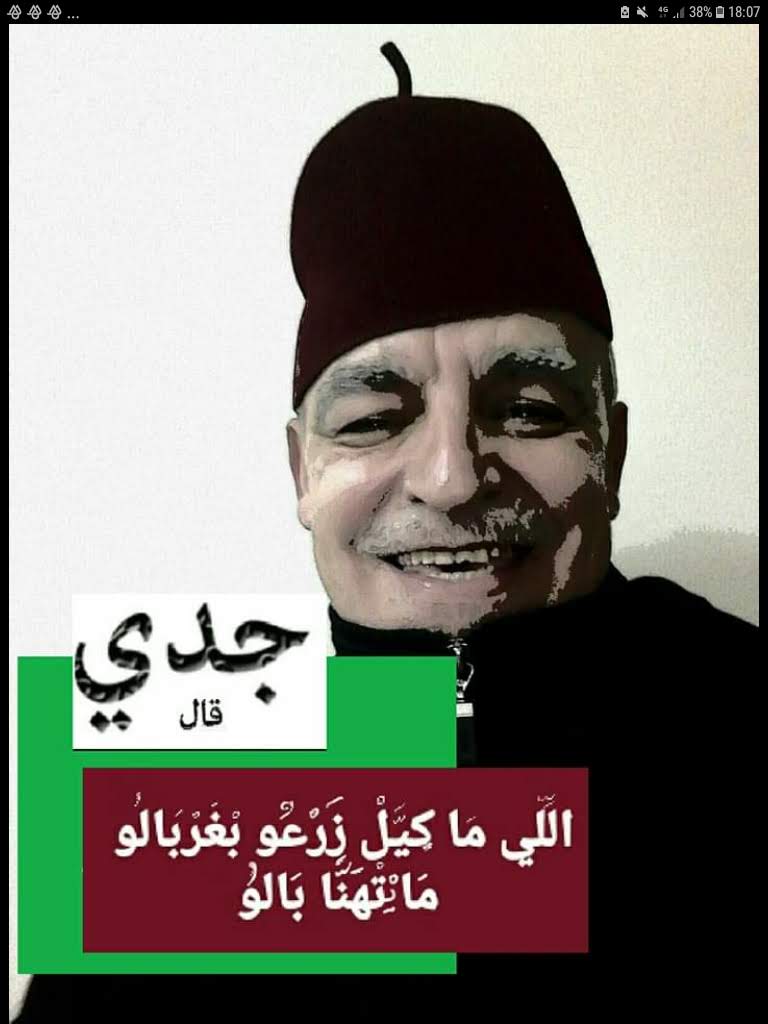
في تلك المرحلة التي بدأ فيها إدريس يفتح قلبه للخشبة ويصقل حسّه المسرحي، وجد نفسه مدفوعًا بفضولٍ حقيقي تجاه عالم التمثيل، كان صديقه أحمد الشيكي، رحمه الله، يرافقه إلى نادي المسرح الشعبي بحي البليدة، حيث كانت التداريب تُجرى مساءً بانتظام، ويعرف مريدو الفرقة مواقيتها الدقيقة، لم يكن إدريس يجرؤ على الدخول إلى القاعة، فكان يقف عند شباك النافذة، يطلّ على عالم جديد يزدحم بالحركة والحوار، ويتنفس منه أولى أنفاسه المسرحية، داخل النادي، كان يشاهد ثلة من رواد فرقة المسرح الشعبي، أحمد البوراشدي، حميد عمور، إدريس الفيلالي، أنوار محمد، الكيسي، والأزرق، رحمهم الله جميعًا، لم يكونوا يملّون من تكرار المشاهد، يعيدون ترتيب اللحظة، ويراجعون الإيقاع، ويتجادلون بلهجتهم الدارجة التي تضفي على التداريب حرارة وصدقًا، كان إدريس آنذاك لا يميّز بين المخرج والممثل، يكتفي بالمراقبة، ويستسلم لدهشة اكتشاف هذا العالم الآسر. وكانت تدخلات “البّا إدريس الملا” (إدريس الفيلالي) خلال التداريب تضفي على المشاهد مسحة كوميدية تلقائية تحوّل بعض اللحظات إلى نوبات ضحك جماعية، وجاءت اللحظة الفارقة حين أتيحت له فرصة الالتحاق بالفرقة في عمل مسرحي بعنوان “ما بين البارح واليوم”، من تأليف الفنان عبد الحق الزروالي وإخراج محمد صوصي علوي(هو اليوم معروف ببابا عاشور)، الذي كان ينادونه بـ “ازدي خويا”، سلّمه المخرج دورًا يقوم على مونولوغ طويل، فرح به إدريس كما لو أنه منحة كبرى، لكنه ما لبث أن انتُزع منه بعد أيام قليلة ليُسند إلى المؤلف نفسه، لم يتذكر إدريس من المونولوغ حرفًا واحدًا، لكن وقع انتزاعه ظلّ حاضرًا في نفسه، حتى إنه رأى في تلك الخطوة البوادر الأولى لميول الزروالي نحو المسرح الفردي، المبني على النفس الطويل واستقلالية الأداء، وحتى لا يغضب ادريس ويهجر الفرقة، كلفه “ازدي خويا” بمهمة التمويج، فظل قريبًا منهم، يتابع ويشارك، ويُبقي خيط الودّ قائمًا، وقد كان إدريس يقدّر أعضاء الفرقة تقديرًا كبيرًا، يناقش معهم قضايا المسرح، خصوصًا البوراشدي وإدريس الفيلالي وحميد عمور، الذين كانوا يبادلونه الاحترام نفسه، وقد كان يرى في أعمال المسرح الشعبي نموذجًا صادقًا وحيًّا للطبقات الشعبية والحرفيين في فاس القديمة، وهو ما كان يلمسه بوضوح خلال عروضهم في سينما ومسرح أبي الجنود أو في دور الشباب، ورغم بساطتهم، كان أعضاء الفرقة يجلّون الفنان المثقف ويحسبون له الحساب في النقاشات، لكنهم ظلّوا أوفياء لنهجهم، مسرح قريب من الناس، بسيطًا في لغته، عميقًا في روحه، يرفع مشعل الفن الشعبي بإخلاص وموهبة لا تخطئها العين.

في انتقاله من المسرح الشعبي إلى الاتحاد الفني، لم يكن إدريس يغيّر فقط فضاءً مسرحيًا، وإنما كان يعبر مرحلة جديدة من صقل هويته الفنية، بدأ الأمر بمهمة بسيطة هي التمويج، غير أنها كانت بوابة إلى عالم أكثر تركيبًا، جمعه بأسماء وازنة مثل عبد العزيز الساقوط، وأحمد الشيكي ، ومحمد فراح العوان، ومحمد نزيه، والدكالي رحمهم الله، وفتّاح الديوري وغيرهم من الوجوه التي صنعت جزءًا مهمًا من ذاكرة المسرح الهاوي في فاس، كان الساقوط، بحسّه المرهف تجاه المواهب، قد سمع بأن إدريس بدأ ينحو نحو الكتابة والتأليف، فكان كلما التقاه في دار الشباب الشياج(أول مقر للمجلس البلدي بفاس) يبادله بعبارته المحبّبة: “واش كاين شي رواية الله يجازيك بخير؟“، والمقصود بالرواية عنده هو المسرحية، كان هذا التشجيع المباشر يدفع إدريس إلى الاجتهاد في كتابة اسكيتشات خاصة تقدَّم عصر يوم الجمعة، حين يكون الصناع التقليديون في عطلة نهاية الأسبوع، فتغصّ ساحة دار الشباب بالعائلات، رجالًا ونساءً وأطفالًا، وفي فترات الاستراحة، كان يصعد إلى الخشبة جوق الفنان الشعبي السي محمد المراكشي، شفاه الله، ليقدم مقاطع شعبية تزيد العرض دفئًا وروحًا فاسية أصيلة، ويتذكر إدريس أن الفرقة تدربت يومًا على مسرحية “صعود وانهيار مراكش” ليوسف فاضل، غير أن الخلافات الداخلية حالت دون تقديمها، وربما كان النص نفسه لا يروق الرئيس، وكان ادريس بحسه النقي يردد في كل اجتماع “لا بد من التصفية، لا بد من التصفية”، في إشارة إلى ضرورة إبعاد من يظنهم معرقِلين لمسار الفرقة، تحوّلت هذه العبارة إلى نكتة يتندّر بها إدريس مع محمد فراح العوان وفتاح الديوري كلما التقوا، فتتعالى الضحكات كل مرة، وكأن الزمن يحتفظ بروح تلك الأيام، ومن المحطات المميزة في هذه المرحلة رحلة صفرو، حيث قدمت الفرقة اسكيتشات مرتجلة، فجاء العرض وليد اللحظة، هناك عاش إدريس أول نشوة حقيقية للارتجال فوق الخشبة، مستعينًا بخبرة المرحوم محمد المريني، كان الارتجال درسًا في الثقة بالنفس وفي القدرة على مواجهة الجمهور دون نص مسبق، ويستعيد إدريس ليلة كاملة قضاها في التدريب على الارتجال مع المريني، بحضور الفنان محمد عادل من فرقة اللواء، وقد سجّلوا تلك التجربة على جهاز المانيطوفون—وثيقة زمنية لا تزال تعيش في ذاكرته. وفي خضم هذه التحولات، ظهرت فرقة الأقنعة التي أسسها التسولي وفتاح الديوري ومحمد فراح العوان وعزيز الحاكم وغيرهم بدار الشباب السياج نفسها، في هذا المحيط، بدأ إدريس يسمع لغة مسرحية مختلفة، مصطلحات مثل الالتزام، الحرية، الأيديولوجيا، الصراع الطبقي، تحطيم الجدار الرابع، بريشت، لغة أكثر عمقًا وتنظيرًا، كشفت له أفقًا آخر للمسرح، غير ذلك الذي عرفه في التلفزة والراديو، كان يظنّ أن التمثيل موهبة فطرية لإضحاك الناس أو تناول قضاياهم ببساطة، لكن التجربة علمته أن المسرح علم وفكر وتاريخ ومدارس وأقطاب، وأن الممثل حامل رؤية، لا مجرد مؤدٍّ، وأن جسده جزء من اللغة، وأن الخشبة فضاءٌ له قوانينه وديناميته، تكوّن هذا الوعي تدريجيًا، عبر انتقاله بين الفرق، وتكثّف بالمشاهدات الحية، وبمتابعة الكتابات النقدية في الصفحات الثقافية للجرائد الوطنية مثل الاتحاد الاشتراكي، العلم، أنوال، والبيان، وبعض الملاحق الثقافية التي عاصرت أوج مسرح الهواة، كان ذلك المسرح، في رأيه، مدرسة حقيقية أنجبت عشرات الفاعلين المسرحيين والثقافيين والإعلاميين، غير أنّ هذه المدرسة تعرّضت لاحقًا لحصارٍ وتقويض دفع مسارها نحو خيارات مرتبطة بالرزق وطلب العيش، أو ما سماه المصريون “الجمهور عايز كده” ويظلّ أكبر شاهد على هذا التحول، بالنسبة لإدريس، هدم معلمة المسرح البلدي بالدار البيضاء في عهد إدريس البصري؛ حدثٌ رمزيٌّ لا يزال يختزن في ذاكرته معنى الانكسار الذي مُنيت به تلك المرحلة، عبر هذا التدرّج والاحتكاك والتجريب، بدأت البذرة المسرحية لدى إدريس تتحول إلى وعي فني وفكري، وتتشكل معالم طريقه بين الفرق والأعمال والمقاربات، من المسرح الشعبي إلى الاتحاد الفني، ومن التمويج إلى الكتابة، ومن الارتجال إلى التأمل في معنى المسرح نفسه.
مع انتقال إدريس إلى ثانوية مولاي رشيد بحي باب الخوخة بفاس، بدأت مرحلة جديدة أكثر نضجًا في مساره المسرحي، هناك وجد نفسه جزءًا من نواة فنية نشيطة ضمّت أحمد الشيكي، ومحمد فراح العوان، والزعيم عبد النعيم، وغيرهم من زملائه الذين تقاسموا معه شغف الخشبة، خلال احتفالات عيد العرش أشرفوا مجتمعين على تنظيم عروض مسرحية وتنشيط ثقافي، تحت الرعاية الإدارية للحارس العام الحوزي، الذي كان يمنحهم مساحة واسعة من الحرية والثقة، ويوفر لهم القاعة والتجهيزات اللازمة، مؤمنًا بقدرتهم على تقديم شيء ذي قيمة، يتذكر إدريس أنهم كانوا يتدربون على مسرحية من تأليفه بعنوان “خياط خاطرو”، وهي تجربة مسرحية مليئة بخفة الظل والمرح، أبدع فيها المرحوم أحمد الشيكي إلى حدّ جعل إدريس نفسه عاجزًا أحيانًا عن ضبط ضحكاته أمام جمهور من الأساتذة والتلاميذ، خصوصًا أثناء البروفات التي كانت تتحول أحيانًا إلى حلقات ارتجال حقيقية. وفي إحدى جلسات التدريب، دخل عليهم الفنان محمد الكغاط، فطلبوا منه مشاهدة مشهد من العمل، أصغى إليهم بعين الخبير، وقدّم لهم جملة من النصائح الفنية والتقنية التي فتحت أمامهم آفاقًا جديدة في التعامل مع الإيقاع والانسجام والبناء الدرامي، كانت تلك أول مرة يلتقي فيها إدريس بهذا الاسم الذي سيحتل لاحقًا موقعًا بارزًا في وجدانه الفني، بعد فترة قصيرة، أصبح الكغاط أستاذًا لإدريس في اللغة العربية، وتحوّلت العلاقة بينهما من مجرد تلميذ وأستاذ إلى علاقة حوار ثقافي وفني، كان الكغاط يتحدث معه عن مسرحياته، ويطلب من بعض التلاميذ تمثيل مقاطع قصيرة داخل الفصل، فيحوّل الدرس إلى ورشة صغيرة للمسرح، تنبض حيوية وتفاعلًا، وقد وجد إدريس في هذا الأسلوب امتدادًا طبيعيًا لشغفه بالمسرح، فكان يتابع تلك اللحظات بشغف، ويتعلم منها ما يفوق ما قد يتعلمه في قاعة تدريب رسمية، ثم جاء الاقتراح الذي سيشكل منعطفًا مهمًا في مساره، حيث دعاه الكغاط إلى الالتحاق بفرقته هواة المسرح بدار الشباب البطحاء، كان ذلك بمثابة اعتراف ضمني بموهبته، وإشارة إلى أنه بات جاهزًا للانتقال من محيط المسرح المدرسي إلى فضاء الهواة، حيث تتعانق الجدية بالموهبة، ويبدأ الفنان أولى خطواته الحقيقية نحو صياغة لغته الخاصة فوق الخشبة.
التحق إدريس رسميًا بفرقة هواة المسرح الوطني، ليجد نفسه بين أسماء بارزة مثل محمد المريني، والعربي الزهراوي، وعبد الغني مرفع، فكان ذلك بداية مرحلة مسرحية أكثر نضجًا واتساعًا، شارك معهم في ثلاثة أعمال مسرحية تركت جميعها أثرًا خاصًا في تجربته. أول هذه الأعمال كانت مسرحية “الحكارة”، من تأليف وإخراج محمد الكغاط وقد قُدّمت على خشبة سينما ومسرح أبي الجنود، حيث لمس إدريس لأول مرة جدية العمل المسرحي الوطني وصرامته، ثم شارك في مسرحية “رجل و.. ورجل”، تأليف محمد تيمد (محمد التيجاني) وإخراج محمد الكغاط، والتي عُرضت بسينما أمبير، هنا تعرّف إدريس على تيمد وجهًا لوجه، وتكوّنت بينهما علاقة فنية أثْرت وعيه الدرامي وأسلوبه في الأداء. أما العمل الثالث فكان مسرحية “بغال الطاحونة”، التي قُدمت بالمسرح البلدي في الدار البيضاء. ورغم مرور الزمن، لم يبق في ذاكرته من تفاصيل العرض سوى ذلك المشهد الذي يخاطب فيه الممثلة بعد أن يدور مع البغال تحت جلد السيد الجاثم على المنبر، وهي الجملة التي ظل يرددها: “كي تسرح في الدوران مثل حمير المعصرة.” كان عرضًا قويًا في رمزيته، وقد استقبلهم خلاله الفنان الراحل زكي العلوي بحفاوة بالغة، فترك لديهم انطباعًا لا يمحى، لم يقف نشاط إدريس عند التمثيل فوق الخشبة، بل انتقل أيضًا إلى الإذاعة، حيث سجّل رفقة محمد الكغاط حلقة أو حلقتين من سلسلة “المسرح العالمي”، إضافة إلى اقتباس لرواية “دفنا الماضي” لعبد الكريم غلاب، وذلك بإذاعة فاس الجهوية. وقد استفاد كثيرًا من تدريبات الإلقاء الإذاعي التي منحت صوته مرونة، وعلّمته دقة النبرة والإيقاع والوقفة.

أما علاقته بجمعية اللواء المسرحي، فقد كانت علاقة قديمة ذات جذور شخصية، إذ كان يعرف رئيسها محمد عادل منذ سنوات الطفولة في حومة سقاية الدمناتي، حيث كان عادل يقطن بدار الضمانة، وبفضل هذه الصلة، دعاه عادل إلى الالتحاق بالفرقة، فشارك معهم في أعمال مميزة، أبرزها “ألف ليلة وليلة” لمحمد تيمد، وهو عمل جمع ثلاث فرق: اللواء المسرحي بفاس، واللواء المسرحي بتازة برئاسة محمد بلهيسي، وفرقة الفصول من مكناس. ثم شارك في مسرحية “عروة يرهن سيفه” للراحل مولاي أحمد العراقي، وهي مسرحية ملحمية ذات نص أدبي رفيع المستوى، غير أنها- في تقدير إدريس- لم تُقدَّم بالصورة الإخراجية التي تليق بعمقها، ولا استوفت شروط العرض التي تتطلبها بنية العمل. وللدلالة على ذلك، يكتفي إدريس بالإشارة إلى المونولوغ الذي ظل منحوتًا في ذاكرته، شاهدًا على قوّة النص وضعف التجسيد، ودليلًا على المسافة بين ما يكتبه الأدب وما تستطيع الخشبة حمله حين لا تتوفر شروط الإبداع كاملة.:
“أهذا قدري يتلبسني
ويضرب أوتاده في شراييني
أم هي الخطيئة الأولى
تنبعث في شرفات شجر التفاح
تزهر نار التيه المخبول
ترسم وشم رؤوس الحية السبع
أم هي كبد حواء تنشطر تحت
طوفان الدم ،تحت صرخات الرأس المفصولة برماح الغدر
ويلاه أأنا الحقير من تلعنني الشمس مرتين ،حين تنشر قميص هابيل في الفجر وحين تلملمه في الغسق
من أنا؟ من أنا ، عوالم تبحر في راس صديقي يسوي رجالها وينفخ الروح في اجنتها
كان الناس لا يعيشون غير حاضرهم فصنع لهم صديقي ماضيا : هذا عروة بن الورد”.
بعد مرحلة تعيينه كأستاذ للغة العربية بالدار البيضاء سنة 1979، اول مسرحية شارك فيها ادريس ضمن الأنشطة المدرسية قدمتها باعدادية حمان الفطواكي نيابة عين السبع وهي” الشمس في بلاد الضباب”، كان قد التقى بالصدفة بمؤلفها احمد العراقي بالرباط فأخذ الضوء الأخضر منه، علما أنه حضر التداريب عليها في دار الشباب البطحاء بفاس، نص المسرحية كتب بمنزل المسرحي الراحل الصديق العزيز عزيز صابر رحمه الل منها ادريس هذه المقدمة:
“أيها الجالسون
على الكراسي المريحة ،
تذخنون السيجارة بهدوء
تشربون القهوة بلذة
تمدون ارجلكم إلى الصغار
ليلعقوا بألسنتهم أحديتكم
ها نحن جئناكم
من متاحف التحنيط جئناكم
نحن في ايدينا الف قناع
فوق مركبنا الف قلاع وقلاع
وفي كل قلاع ألف رقعة ورقعة
كالعادة جئناكم محمل الهدية
الهدية مرآة
وفي المرآة الف حكاية وحكاية”. هذه المسرحية أجهض عرضها بالمؤسسة رغم تتبع ادريس وتطبيقه لجميع الاجراءات الإدارية بإيعاز من حارس عام كان يكن الحسد والبغض لكل ما هو فاسي، والذي أثار انتباهه أنه مباشرة بعد توقيف عرض المسرحية بخمس دقائق، لم يستسغ التلاميذ الذين شاركوا في التداريب على مدة أكثر من شهر، هذا المنع فانتقموا لأنفسهم وخرجوا وبدؤوا يرمون بالحجارة في اتجاه الإدارة، بينما التحق ادريس بأعصاب باردة إلى مكتب المدير العلام اخ العقيد المغربي العلام الذي استشهد في الجولان مع التجريدة المغربية في الحرب، واستفسره عن أسباب المنع، فلم يصرح لي بأي شيء، من بعد فهم ادريس من اين جاءت ضربة المنع.
حين انتقل إدريس إلى إعدادية يوسف بن تاشفين التابعة لنيابة الفداء درب السلطان بالدار البيضاء، حمل معه الحماس ذاته الذي رافقه منذ بداياته، وكأنه يفتتح صفحة جديدة في مشروعه الثقافي والتربوي وفي جعبته مراس مسرحي ورغبة في الاستمرار في التربية على قيم الفن والعلم، وما إن وطئت قدماه المؤسسة حتى شرع، مرة أخرى، في بث روح التنشيط الفني داخل أروقتها، واضعًا نصب عينيه هدفًا بدا بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق الدلالة، ترسيخ ثقافة الاعتراف من خلال تكريم الأساتذة والإداريين وإشراكهم في نبض الحياة المدرسية، حتى يشعر كل فرد بأن جهده مرئي وأن صوته مسموع، غير أنّ هذا الطريق، كما اعتاد إدريس، لم يكن مفروشًا بالورود، فقد واصل صدامه مع بعض العقليات الإدارية المتصلّبة، التي كانت ترى في أي نشاط ثقافي تهديدًا لنظام اعتادت التحكم فيه. كانوا يضعون العراقيل، ويستندون إلى قراءة ضيقة للنظام الداخلي، بينما كان إدريس يواجه ذلك بثبات، متمسكًا بحقه في العمل ضمن الحدود التربوية والقانونية، لا يتجاوزها ولا يسمح لأحد بأن يصادر منه شغفه. في وسط هذه التجاذبات، نجح في تقديم أعمال مسرحية ذات أهداف واضحة وعمق تربوي، من بينها مسرحية “لقرايا فالمرايا”، التي صاغها بمزج بين النقد الاجتماعي والتحفيز الدراسي، جاعلًا منها مرآة يرى فيها التلاميذ يومياتهم وهواجسهم. ثم مضى خطوة أخرى، فحوّل حصص اللغة العربية إلى فضاءات أدائية حيّة: قراءات شعرية ممسرحة، مشاهد صغيرة تُشخّص داخل القسم، ومقاطع من مسرحية “أهل الكهف” لتوفيق الحكيم، يؤديها التلاميذ والتلميذات بتقمص وتفاعل، كان هدفه أعمق من مجرد أنشطة موازية؛ كان يسعى إلى فتح نافذة على تاريخ المسرح ومدارسه، وإلى تعريف الجيل الصاعد بعمالقة الركح المغربي، وفي مقدمتهم الطيب الصديقي والحسين العلج، اللذين شكّلا معًا مدرسة قائمة بذاتها في الإبداع المسرحي. أراد إدريس أن يدرك تلاميذه أن المسرح ليس ترفًا، بل أداة تفكير، ومرآة هوية، ومنصة لتعلم الحرية والمسؤولية، ورغم المقاومة التي واجهته، ظل ماضياً في مشروعه الثقافي، منصتًا إلى نبض التلاميذ أكثر من أصوات المكاتب، مؤمنًا بأن كل مؤسسة تعليمية يمكن أن تصبح مسرحًا صغيرًا، ينهض فيه الخيال من مقاعد الدرس ليتحول إلى حركة، وصوت، وحكاية.
ظلّ إدريس العمارتي، وفيًّا للخشبة، يتابع نبض المسرح كما يتابع المريد شيخه، قراءةً، وكتابةً، وحضورًا في الفعاليات والعروض، خصوصًا تلك التي كانت تحتضنها مدينة الدار البيضاء، لم يكن المسرح بالنسبة إليه فنًّا يُستهلك، بل حياة تُعاش، ومسارًا داخليًّا لا يهدأ، لذلك كان ملازمًا للمسرحي الراحل عزيز صابر، ينهلان معًا من ذاكرة المسرح الفاسي والمغربي، ويستعيدان أسماء وتجارب وأمكنة صنعت إرثًا لا يزال حيًّا في وجدانهماK وكلما زار الفنان إبراهيم الدمناتي الدار البيضاء، كان إدريس حريصًا على حضور تلك الجلسات التي تحوّلت مع مرور السنوات إلى سُنّة فنية مؤكدة، لا يتخلّف عنها إلا لعذر قاهر، من تلك اللقاءات تعلّم كثيرًا، واستوعب أكثر، حتى غدت جزءًا من تكوينه الثقافي والوجداني. بعد سنوات من التدريس والتنشيط في المؤسسات العمومية، التحق إدريس بجمعية تعنى بـتلاميذ الفرصة الثانية، فوجد هناك امتدادًا طبيعيًا لرسالته التربوية، عمل أستاذًا للغة العربية، لكنه سرعان ما تجاوز حدود المادة الدراسية ليصبح منسّقًا ثقافيًا ومؤطرًا فنيًا، رأى في أولئك الشباب الذين تعثروا في دراستهم أو حياتهم مرايا صغيرة تعكس مجتمعًا أكبر، فقرّر أن يفتح لهم بابًا نحو المسرح باعتباره مسلكًا للتعبير وفضاءً لاستعادة الثقة. علّمهم المبادئ الأولى لفن التمثيل، وكتب معهم سكيتشات ومشاهد مأخوذة من واقعهم، حتى يشعر كل واحد منهم أنه صاحب حكاية تستحق أن تُروى. من بين الأعمال التي قدّمها معهم مسرحية “من هنا تشرق الشمس”، التي أنجزت بنسختين عربية وفرنسية لتوسيع دائرة الفهم والتلقي، ثم مسرحية “حلاق درب لِنْكْليز”، إلى جانب أعمال أخرى صنعت في مجموعها مسارًا دافئًا، يختلط فيه الفن بالعلاج النفسي والاجتماعي. كان إدريس يؤمن أن المسرح يستطيع أن يمنح هؤلاء التلاميذ ما فقدوه: الاعتراف، والانصات، والقدرة على الوقوف أمام الآخر دون خوف.
وحين سألته لماذا اختار إدريس المسرح؟ يجد السؤال أكثر من جواب، ربّما اختاره بسبب خجله الذي كان يبحث عن متنفس، أو بسبب وضعه الاجتماعي الذي كان يتلمس فيه مصائر طبقته ووجعها، وربما لأن المسرح كان بالنسبة إليه ساحة مواجهة مع الإنسان في خبثه وجبروته، كان يدرك أن الصعود إلى الخشبة ليس مجرد أداء، بل لحظة مواجهة، ومحاسبة للذات وللمجتمع في آن واحد. كان يرى في الأضواء مسرحًا داخليًا أكثر مما يراه مجرّد خشبة، إدريس لم يكن ممثلًا مشهورًا، ولم يشارك إلا في عدد محدود من المسرحيات خلال فترة مسرح الهواة، لكنه ظلّ يفتخر بهذه التجربة وبأهلها من رجال ونساء. لم يسعَ يومًا إلى التقرب من المؤلفين أو المخرجين أو الوسطاء طمعًا في دور أو حضور أو شهرة. كان يؤمن بأن ما مُنح له في الخفاء من أحاسيس فنية وإنسانية، أعمق وأكثر صدقًا من أن تُختزل في اسم يلمع على ملصق أو على شاشة. وفي لحظة بوح صادق، كان يعترف بعِيبه الوحيد كما يسميه، أنه خلال السبعينيات كان مشتّت الاهتمامات بين كتابة القصة والمقالة والنقد الأدبي والفني، ولم يستطع أن يحسم اختياره مبكرًا. وحين ظهر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي انجذب إلى عوالم جديدة فتحت أمامه أبوابًا أخرى للكتابة والتفاعل، وكان في داخله دائمًا حلم صغير، أن يؤلّف مسرحية واحدة تضعه في زمرة المؤلفين المسرحيين الكبار. غير أنه، مع مرور الزمن، أدرك أن كثيرًا من المؤلفين الذين عاشوا للمسرح ووهبوا له كل شيء، صاروا اليوم في طيّ النسيان. فخفّ عنه ثقل ذلك الحلم، ورضي بما كتب وقدّم، معتبرًا أن الكلمة التي قالها ـ بالقدر الذي سمحت به ظروفه وظروف جيله ـ كانت كافية.
كتب إدريس مقالات عديدة، وما زال ينشر كتاباته في جريدة العلم إلى اليوم، ورسم بورتريهات لوجوه مسرحية لم تعد الصحافة تذكرها، محاولًا أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من الذاكرة المسرحية المغربية. كان يعرف أنه لم يُكمل الجملة المسرحية التي حلم بها، لكنه كان مقتنعًا أنه لا أحد يستطيع أن يكملها كاملة، فـ”لكل شيء إذا ما تمّ نقصان”، لم يكن مسار إدريس مسار نجم يسعى إلى الأضواء، بل كان مسار رجل ظلّ، يعمل في الهامش ليضيء المركز، ويزرع في التلاميذ والجيل الجديد حب المسرح والقراءة والحياة، ظلّ أمينًا للخشبة، مؤمنًا بدورها في التربية والاحتجاج والتطهير. وربما كانت أعظم إنجازاته ليست تلك التي كتبها أو مثّلها، بل الأثر الهادئ الذي تركه في نفوس من علّمهم ورافقهم. فإدريس العمارتي لم يطلب من المسرح مجدًا، بل طلب منه معنى، وقد وجده.

