قراءة في مسيرة الفنان محمد خشلة: من مفهوم التكامل في الرياضيات إلى مفهوم التمسرح في الدراسات المسرحية، حوّل الرمال إلى مسرح، والهامش إلى قلب المشهد


وُلد الفنان محمد خشلة سنة 1951 بحيّ مولاي عبد الله، ذلك الحيّ الوادع المحيط بأسوار القصر الملكي بفاس، حيث تتجاور السلطة والسكينة، وتختلط هيبة الحجر برهافة الزهر. كانت الدور المحاذية لصور القصر تتكئ على ساحة ملكية شاسعة، لكلّ منها منفذ خاص يفضي مباشرة إلى الداخل، خُصّص لخدام القصر الذين سكنوا الحيّ جيلاً بعد جيل، في ظلال الأسوار العالية، تنفّس محمد طفولته الأولى، طفولة وردية تشبه ألوان الأزهار التي كانت تزيّن حدائق القصر، وتضفي على المكان سحرًا خاصًا لا يعرفه إلا من نشأ على مقربة من الحُلم والسلطة معًا. خطا خطواته التعليمية الأولى في المسيد (الكُتّاب) بحارة سيدي بونافع، حيث كان ضريح الوليّ الصالح يحتضن المكان، فيتحوّل التعلّم إلى طقس روحاني، تختلط فيه آيات القرآن برائحة البخور وبخشوع الوجوه الصغيرة، كانت الحارة محاذية لحيّ الملاح، حيث تقيم معظم الجالية اليهودية آنذاك، فشبّ محمد منذ نعومة أظفاره على التنوّع والتعدّد، وتعرّف على أطفال من ثقافات وأديان مختلفة، تقاسم معهم اللعب والضحك والمشاغبة، دون أن تعي براءته الفتية حدود الاختلاف. كان الصبيّ الصغير، الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، يقطع المسافة الفاصلة بين حي مولاي عبد الله وحارة سيدي بونافع مرورًا بالشارع التجاري لحي فاس الجديد، خطواته الصغيرة تتهادى بين الدكاكين والباعة، وكأن المدينة كانت تمدّ له ذراعيها منذ ذلك الحين، تعلّمه أول دروس الاكتشاف والمشاهدة والانتباه لأدقّ التفاصيل. غير أنّ هذا العالم المترف بالحياة لم يدم طويلًا، ففي يوم غامض، وبدون سابق إنذار، انتقلت العائلة فجأة من ذلك الوسط الحضاري الدافئ – من منزل الجدّ الذي كان يعجّ بالحركة والحب والذاكرة – إلى حيّ ابن ذباب، الحيّ الفقير الذي كان حينها في طور التكوّن، نتاجًا لهجرة قاسية لسكان البوادي المحيطة بفاس، كان الانتقال أشبه بالهبوط المفاجئ من حلم ملوّن إلى واقع عارٍ، من فضاء تحرسه الأسوار الملكية إلى هامشٍ تتكوّن ملامحه من الطين والبؤس والصبر. لم تكد العائلة تستقرّ في هذا الحي الجديد حتى فُجعت بموت الأم، فغاب الدفء فجأة من البيت، وانطفأت شمعة الحنان التي كانت تحمي الأطفال من قسوة العالم، وجد محمد نفسه، ومعه إخوته الخمسة، تحت رعاية امرأة أب بدوية، تجهل سُنن الحياة الحضرية، ولا تمتلك من أدوات التعامل مع المدينة سوى القسوة الفطرية التي صاغتها حياة البادية، وهناك، بدأ الفقد يتسلّل إلى روحه الصغيرة، لا كخبر عابر، وإنما كجرح مفتوح سيترك أثره العميق في وجدانه ومساره لاحقًا. دخل محمد مرحلة التعليم الابتدائي بمدرسة ابن ذباب، وسط أبناء المهاجرين الفقراء، حيث تتجاور الأحلام الهشة مع الحاجة اليومية إلى البقاء. ومن بين تلك الوجوه الطفولية المرهقة، انتقى بحدس بريء صديق عمره، طفلًا اسمه بوشتى كانت صداقة وُلدت من رحم العوز والتشارك في القلق واللعب والخوف، لكنها ستتوطّد مع السنين، وتتحوّل إلى واحدة من أعمق الصداقات في حياته، ذلك الطفل سيُعرف لاحقًا باسم الكاتب والروائي المرحوم المهدي الحاضي الحمياني، وكأن القدر كان يُخفي في زوايا الفقر بذور الإبداع المبكر. هكذا تشكّلت البدايات الأولى لمحمد خشلة، بين ظلّ القصر وضيق الهامش، بين دفء الأم وقسوة اليُتم، بين لعب الطفولة وانكسارات الواقع. ومن هذه التناقضات الصارخة، بدأ الحسّ الفني يتسرّب إلى روحه دون أن يدري، كأن الألم نفسه كان يرسم له الطريق نحو الفن، بصمتٍ طويل وعميق.

لم يكن محمد خشلة مستأنسًا بتلك الحياة المشبعة بروح البداوة التي فُرضت عليه في ستينيات القرن المنصرم، كان يشعر، وهو بعدُ في مقتبل العمر، بأن شيئًا ما يُنتزع من روحه كل يوم، وأن فردوسًا ضائعًا يناديه من وراء جدران الحيّ الفقير، لذلك كان كثير الهروب، لا جسديًا فقط، وإنما روحيًا أيضًا، متتبعًا دروب المدينة العتيقة، كمن يبحث عن ذاته بين الأزقة المتعرّجة والوجوه العتيقة.كانت خطوته الأولى في هذا المسار التحاقه بجمعية حركة الطفولة الشعبية والتي كانت تزاول أنشطتها خلال الستينيات من القرن المنصرم بالدار رقم 76 بدرب بوعزة بحي البليدة برعاية عبد العزيز الدباغ، وهو من صمم شعار حركة الطفولة الشعبية مع بعض التعديلات المتعلقة بالنجمة والخط صممها غيره، المسافة بين حيّ أكادير، حيث كان يسكن، وحيّ البليدة، كانت تستغرق ساعة ونصف تقريبًا مشيًا على الأقدام، لكنه كان يقطعها بشغف لا يعرف التعب، غير أنّ الطريق لم تكن مجرد مسافة، بل كانت تجربة اكتشاف يومي، إذ كان لا بد له، في كل مرة، أن يمرّ قرب مقر جمعية المسرح الشعبي بدري سيدي عمر الصقلي بحي شوارة، وهناك، كان يتوقّف مسحورًا أمام النافذة، يتلصّص على التداريب التمثيلية، وتتسمّر عيناه على حركة الممثلين وهم يتشكّلون فوق الخشبة، كثيرًا ما كان هذا السحر يؤخّره عن الوصول إلى مقر جمعية الطفولة الشعبية، لكنه لم يكن يعدّ ذلك خسارة، بل ربحًا خفيًا لروح بدأت تتوق إلى التعبير.في هذه المرحلة، التحق بإعدادية باب ريافة، وهناك اتّسعت دائرة معارفه، واكتسب أصدقاء من أبناء المدينة العتيقة، ربطته بهم أواصر اليوميّ والمغامرة والاكتشاف. ومن خلالهم، تعرّف على النادي الثقافي بحيّ البطحاء، (اليوم دار الشباب البطحاء)، حيث ستُفتح أمامه بوّابة جديدة نحو عالم الفن. في هذا الفضاء، تلقّى مبادئه الأولى في الفنون التشكيلية والموسيقى، وبدأ وعيه الجمالي يتشكّل تدريجيًا.كان ذلك الزمن، بكلّ قسوته وتناقضاته، يهيّئه بصمت لقدرٍ آخر، لم يكن قد تبيّن معالمه بعد، لكنه كان يتسرّب إلى داخله كما يتسرّب الضوء من شقوق نافذة مسرح.

خلال مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، كان محمد يعيش صراعًا داخليًا عميقًا، صراعًا لم يكن مصدره الفقر وحده ولا ضيق العيش، بل ذلك الإحساس الجارح بالاختلاف الذي زرعته بشرته السوداء في نظره ونظر الآخرين، لم يكن الطفل قادراً بعدُ على فهم قسوة العالم ولا منطق التراتبية الخفية التي تصنعها الألوان، لكنه كان يشعر بالطعنة كلما لاحقه أقرانه، بل وحتى بعض الراشدين، بنعوت جارحة تحيله إلى مجرد لون: “العنطيز”، “الدراوي”، “لكحل””عزي”… كلمات كانت تهوي على قلبه كالحجارة.كان محمد يواجه هذا القهر بعنفٍ غريزي، دفاعًا عن كرامته المجروحة أكثر مما هو اندفاع أعمى، لم يكن يرى في قبضته سوى الوسيلة الوحيدة لإسكات الإهانة، فدخل في شجارات متكررة مع كل من تمادى في السخرية منه. ومع توالي المشاحنات، لم تتسامح المؤسسة التعليمية مع “سلوكه العنيف”، فكان القرار القاسي، الطرد من إعدادية باب ريافة، ونقله قسرًا إلى إعدادية ابن البنّاء، التي كانت آنذاك داخل الحرم الجامعي ظهر المهراز.كان هذا الانتقال أشبه بنفيٍ غير معلن، فالإعدادية الجديدة كانت تبعد عن بيت أسرته بحيّ أكادير ساعةً ونصفًا مشيًا على الأقدام، لم يكن يملك خمسة عشر سنتيمًا ثمن تذكرة الحافلة، فكان يقطع الطريق يوميًا تحت الشمس والمطر، محمّلًا بثقل الجسد وغصّة النفس معًا. غير أن الجرح الوجودي ظلّ ينزف داخله، ولم تهدأ نوباته مع الإهانة، فسرعان ما تكرر السيناريو نفسه: مشاحنات، صدامات، ثم طرد آخر، هذه المرة من إعدادية ابن البنّاء، لينقطع بعدها عن الدراسة تمامًا.غير أن ما بدا في ظاهره ضياعًا كاملًا، كان في باطنه قدرًا يتشكل بصمت. فخلال الفترة القصيرة التي قضاها بإعدادية ابن البنّاء، انفتح أمام محمد عالم لم يكن يحسب له حسابًا، داخل فضاء ظهر المهراز، تعرف على مجموعة من الشباب المنتمين إلى جمعية المسرح الشعبي: محمد لشهب، محمد لكحل، أحمد العراقي، ومحمد البوكيلي. كانوا يدرسون بثانوية ابن كيران المعرّبة، الواقعة بدورها داخل الحرم الجامعي نفسه، شدّه إليهم حديثهم المختلف، لغتهم المشبعة بالحلم والخشبة والتمثيل، كأنهم يفتحون أمامه بابًا سريًا نحو عالم آخر.وخلال تلك اللقاءات، تعرّف أيضًا على صديقه محمد الدرهم، الذي سيصبح لاحقًا عضوًا مؤسسًا لفرقة جيل جيلالة الشهيرة. كان محمد الدرهم يدرس بمعهد الجلد والنسيج، الذي كان بدوره جزءًا من ذلك الفضاء الجامعي نفسه. ومن خلال هذا الصديق، سيفتح الباب أمام محمد للالتحاق بجمعية النجاح الفني المسرحية، التي كان مقرها بالمدينة الجديدة، بدار دبيبغ، بدأ محمد يقترب فعليًا من عالم المسرح والحلم الجماعي، يكتشف لذة الوقوف أمام الركح، وسحر الضوء والحركة والكلمة. غير أن المسارات لا تستقيم دائمًا؛ فمحمد الدرهم سيعود لاحقًا إلى مدينته مراكش بعد نهاية دراسته بمعهد الجلد والنسيج، بينما سيجد محمد نفسه مدفوعًا إلى أفق جديد أكثر عمقًا وتأثيرًا: الانضمام إلى جمعية الطليعة، التي كان يرأسها الفنان المسرحي الكبير، المرحوم أحمد زكي العلوي.كان مقر الجمعية داخل الكنيسة الكاثوليكية بشارع السلاوي، المؤدي إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله. ولم تكن جمعية الطليعة مجرد جمعية هاوية كسواها من الجمعيات، وإنما كانت فضاءً حيًّا يعجّ بالإبداع والانضباط والتكوين الصارم. كانت تحتضن نخبة من ألمع المسرحيين بمدينة فاس، من بينهم محمد التيجاني المعروف بـ(تيمد)، ومحمد الكغاط، وإبراهيم الدمناتي، إضافة إلى صفوة من طلبة كلية الآداب وأساتذة مولعين بالمسرح، كان من أبرزهم الأستاذ حميد بن الشريف، مدير ثانوية ابن خلدون آنذاك.وكان لهذا الأخير فضل حاسم في مسار محمد، إذ كان السبب المباشر في عودته إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام سنتين كاملتين. هكذا عاد محمد إلى التعليم، لا من باب الواجب وحده، بل من منطلق وعي جديد بقيمة المعرفة ودورها في تشكيل الفنان والإنسان معًا.التحق محمد بجمعية الطليعة رفقة مجموعة من المراهقين الجدد، من بينهم صديقا طفولته، المهدي الحاضي الحمياني ومحمد المريني رحمهما الله، لتعويض قدماء الجمعية الذين أنهوا دراستهم الجامعية وعيّنوا في مدن أخرى، وجد محمد ذاته كما لم يجدها من قبل. لم تكن الطليعة بالنسبة إليه مجرد فضاء للتمثيل، بل كانت مرهمًا عميقًا لكل الجراح الاجتماعية القديمة، ومختبرًا حقيقيًا لبناء الوعي والهوية.داخل هذا الفضاء، أدرك محمد لأول مرة المعنى الحقيقي للثقافة، أقبل على المطالعة بنهمٍ لا يشبع، رغم توجهه العلمي في الدراسة الثانوية. قرأ الأدب الروسي والفرنسي في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، واكتشف المسرح الكلاسيكي، والمسرح المغربي، وتذوّق حلاوة الجولات المسرحية داخل المغرب، ثم في القطر الجزائري الشقيق. شيئًا فشيئًا، بدأت ملامح شخصيته المسرحية تتبلور، مختلفة، حادة، ومشبعة بالتجربة والمعاناة. غير أنّ هذا المسار المتوهّج سيتعرض لاهتزاز جديد حين تقاعد أحمد زكي العلوي من مهنة التدريس، وانتقل للعيش والعمل في مجال الإعلام والإشهار بمدينة الدار البيضاء. آنذاك، وجد محمد نفسه في مفترق طرق حاسم، حائرًا بين الاستمرار في الطريق الذي شُقّ داخل جمعية الطليعة، أو البحث عن أفق آخر يضمن له استمرارية الحلم الذي بدأ يتشكّل من رحم الألم.

خلال سبعينيات القرن المنصرم، كانت مدينة فاس تعيش واحدة من أكثر مراحلها المسرحية توهّجًا وحيوية، مرحلة جعلتها تتقدّم بثبات نحو ريادة وطنية لا تنازع. لم يكن ذلك الزمن مجرد فترة ازدهار عابر، وإنما كان لحظة تاريخية كثيفة، تداخل فيها الإبداع الفني مع الأسئلة الفكرية الكبرى، وبلغ فيها الصراع الجمالي والإيديولوجي ذروته بين الفرق المسرحية الفاسية التي شكلت، كل واحدة منها، اتجاهًا ورؤية ومشروعًا مختلفًا. كانت الساحة تعجّ بأسماء أصبحت فيما بعد علامات بارزة في تاريخ المسرح المغربي، تتوزع بين فرق المسرح الشعبي، والطليعة، والهواة، والأقنعة، واللواء، والاتحاد الفني، وغيرها من التجارب التي لم تكن متشابهة في رؤاها ولا في لغتها الفنية. كان الخلاف بينها عميقًا، أحيانًا محمومًا، لكنه كان خلافًا منتجًا، يشحذ الأسئلة ويوقظ الوعي، ويدفع المسرحيين إلى البحث الدائم عن صيغ جديدة للتعبير، وعن موقع الفن في قلب المجتمع والتحولات السياسية والفكرية التي يعيشها المغرب آنذاك. لم يكن التنافس بين هذه الفرق صراعًا على الجمهور وحده، بل كان مواجهة مفتوحة بين تصورات مختلفة للمسرح: مسرح ينحاز إلى الشعبية والهمّ اليومي، وآخر يطمح إلى التجريب والجمالية العالية، وثالث يشتغل على الرموز والأسئلة الوجودية، ورابع يجعل من الالتزام السياسي جوهر خطابه. وفي خضم هذا التنوّع المربك والخلاّق معًا، تبلورت هوية مسرحية فاسية خاصة، صلبة، جريئة، ومنفتحة على التيارات العالمية دون أن تنسخها. هذا الزخم جعل من فاس منارةً فنية وفكرية يشعّ نورها على مختلف المدن والأقاليم المغربية. فقد كانت المدينة آنذاك لا تنتج العروض فقط، بل تنتج الأفكار والجدل والنقاش والتكوين. ولعلّ السرّ العميق في هذا الإشعاع يعود إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله، التي كانت تحتضن في مدرجاتها نخبة من الطلبة الذين سيصبحون لاحقًا أعمدة في الحركة المسرحية والثقافية والعلمية بالمغرب. كانت الجامعة بمثابة الرافد النظري والفكري الذي يغذّي الخشبة، ويمنح الممارسة المسرحية عمقها النقدي وأفقها التغييري. لم تكن فاس في السبعينيات مجرد مدينة تنتج عروضًا مسرحية ناجحة، وإنما فضاءً لصناعة الوعي، ومختبرًا لتقاطع الفن بالفكر وبالسياسة، ومشتلاً حقيقيًا لأجيال من المبدعين الذين سيحملون مشعل المسرح المغربي إلى فضاءات أوسع، داخل الوطن وخارجه.
بعد رحيل أستاذه ومرشده الفني أحمد زكي العلوي، وجد محمد نفسه أمام فراغٍ قاسٍ، لكنه لم يستسلم له، كان الفقد قاسيًا، غير أنّ الرغبة في الاستمرار كانت أشدّ عنادًا. أعاد الاتصال بزملائه من تلامذة ثانوية ابن كيران، أولئك الذين تقاسم معهم الحلم والقلق والبدايات الأولى، فالتحقوا جميعًا بجمعية الاتحاد الفني التي كان يرأسها المناضل المرحوم عبد العزيز الساقوط بدار الشباب البطحاء، الرجل الذي جمع بين الالتزام السياسي والشغف المسرحي. داخل هذا الفضاء الجديد، خطا محمد واحدة من أهم خطواته المفصلية، إذ أخرج أول عمل مسرحي في مسيرته بعنوان “حزيران: شهادة ميلاد”، نصّ للكاتب المسرحي أحمد العراقي. لم يكن العرض مغامرة فردية، وإنما ثمرة عمل جماعي تشكّل من نخبة من شباب المسرح آنذاك، محمد لشهب، ومحمد البوكيلي، ومحمد الريحاني، وفاطمة الوكيلي، ورشيد جبوج، وعمر الدوييب، وبوميز، وعبد الحق الزروالي. بهذا العمل، مثّلت الفرقة مدينة فاس في الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الوطني لمسرح الهواة بطنجة سنة 1973، في لحظة مفصلية كرّست حضور محمد مخرجًا صاعدًا، وبصّمت اسمه لأول مرة في سجل التظاهرات الوطنية. كانت تلك المرحلة من حياته مشبعة بروح التحدي والرغبة في إثبات الذات، ليس في المسرح وحده، بل في الفنون التشكيلية أيضًا، إلى جانب سعيه الجادّ لنيل شهادة الباكالوريا في العلوم، كان محمد يعيش زمنًا مزدحمًا بالطموح، موزّعًا بين الخشبة، والمرسم، وقاعات الدرس، وكأن الزمن لا يتّسع لكل اندفاعه.وخلال دراسته الثانوية، حرص محمد على أن يجعل من التكوين المستمر جزءًا من مساره، فشارك في جميع الدورات التكوينية في المسرح التي كان ينظمها المركز الثقافي الفرنسي (المعهد الفرنسي حاليًا ) داخل المغرب وخارجه، سافر إلى مونبولييه وأفينيون وليل بفرنسا، حيث احتك بتجارب مسرحية مختلفة، واطّلع على تقنيات جديدة في الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا، فازدادت رؤيته اتساعًا وعمقًا، وتحرّر وعيه الجمالي من حدود المحلي دون أن يفقد جذوره. أما على مستوى الفنون التشكيلية، فلم يكن نشاطه أقلّ كثافة، إذ شارك في عدد من المعارض الجماعية والفردية، مؤكّدًا حضوره كفنان مزدوج الرؤية، يتقاطع فيه المسرح مع اللوحة، والحركة مع اللون، والركح مع الفضاء البصري. هكذا كانت تلك المرحلة مرحلة تشكّل حاسمة، التقت فيها الدراسة بالطموح، والتكوين بالمغامرة، والرغبة في إثبات الذات بجرأة البدايات الأولى.

حصل محمد على شهادة الباكالوريا سنة 1976، وكان ذلك إنجازًا شخصيًا كبيرًا في سياق حياة شقّتها العوائق الاجتماعية والاقتصادية، بدافع من طموح علمي ورغبة في اختراق مجال النخبة، التحق بكلية الطب، حالمًا بمستقبل يضعه في مصافّ الأطباء. غير أن هذا الحلم لم يصمد طويلًا أمام واقع قاسٍ، إذ سرعان ما تضافر العوز المادي مع ذلك الهوس الفني العميق الذي كان يسكنه، فوجد نفسه عاجزًا عن الاستمرار في هذا المسار الأكاديمي الصارم الذي يتطلب تفرغًا كاملًا وموارد لا يملكها. أمام ضغط الواقع، اضطر محمد إلى اتخاذ قرار مصيري: الزواج من جهة، والالتحاق بمهنة تدريس الرياضيات من جهة أخرى، فعُيّن أستاذًا بثانوية أم أيمن بمدينة فاس، داخل فضاء الثانوية، لم يجد مجرد وظيفة يعيش منها، وإنما وجد مختبرًا جديدًا لأفكاره، ومجالًا رحبًا لتجريب هواجسه الفنية والفكرية. وما إن وطئت قدماه الثانوية حتى عُيّن منشّطًا بها، رغم أن الأستاذ المسرحي المرحوم محمد الكغاط كان قد سبقه إلى العمل فيها، غير أن هذا لم يثنه عن المضيّ في مشروعه، بل حفّزه على خلق بصمته الخاصة بعيدًا عن التكرار. في تلك المرحلة، بدأ يفكر جديا في بلورة منهج فكري وفني يميّزه عن غيره من المسرحيين المغاربة، لم يكن يريد أن يكون مجرد مخرج آخر، بل صاحب رؤية مختلفة، إلى جانب عمله بثانوية أم أيمن، حرص على تنظيم مهرجان المسرح المدرسي بثانوية مولاي إدريس، بمعية مجموعة من الأطر التربوية، على رأسهم صديق طفولته المهدي الحاضي الحمياني. وهكذا، تحوّلت المدرسة من فضاء تلقين جامد إلى فضاء حيّ للإبداع والتجريب. لم يكتف محمد بالنشاط التنظيمي، بل جعل من ثانوية أم أيمن وثانوية أم البنين مختبرًا عمليًا لتطوير ما سيُعرف لاحقًا بـ”نظرية مسرح التكامل”. كانت هذه الفكرة قد بدأت تتشكل في ذهنه منذ إخراجه لمسرحية “حزيران: شهادة ميلاد”، التي جاءت في شكل كوريغرافيا مسرحية غير مألوفة، خرجت عن القوالب السائدة في المسرح المغربي آنذاك. كان العمل أقرب إلى لوحة متحركة، تحتكم إلى الإيقاع البصري والجسدي بقدر ما تحتكم إلى الكلمة. داخل ثانوية أم أيمن، أعاد محمد إنتاج عدد من المسرحيات الكلاسيكية والمعاصرة وفق تصورات جديدة، موظفًا التقنيات الحديثة التي كان قد اطّلع عليها من خلال مشاركته في تدريبات المسرح الفرنسي المعاصر. لم يكن ينقل التجربة كما هي، بل كان يعيد تفكيكها، ويزرعها في تربة محلية، باحثًا عن لغة مسرحية تزاوج بين الحداثة والهوية. وفي قلب هذا المشروع، كان يحاول، بجرأة فكرية لافتة، توظيف معارفه المتعددة، الفنون التشكيلية، وتدريس الرياضيات، وبالخصوص حساب التكامل الذي كان يستحوذ على فكره منذ أيام الباكالوريا. لم يكن ينظر إلى الرياضيات باعتبارها علمًا جافًا، بل كنسق فلسفيّ عميق، قائم على التجريد، واللانهاية، والتراكم، والاستمرارية. ومن هنا، بدأ إسقاط المفاهيم التجريدية للتكامل على الإخراج المسرحي، وخاصة فيما يتعلّق بمفهوم التمسرح. كان يشرح فكرته قائلًا إن “التكامل في الرياضيات هو حاصل جمع كميات صغيرة جدًا بلا نهاية، بطريقة تجعل النتيجة تمثل كمية كلية مستمرة، كالمساحة أو المسافة أو الحجم”، وعلى المستوى الرمزي، كان يرى أن العرض المسرحي الناجح هو بدوره حاصل جمع عدد لا يُحصى من التفاصيل الصغيرة، حركة، نظرة، ضوء، صمت، جملة، إيقاع… كلّها، مجتمعة، تصنع الكلّ المتكامل الذي يصل إلى المتفرج. وكما أن الصيغة الرياضية للتكامل تقوم على جمع قيم متناهية في الصغر ضمن مجال معيّن للوصول إلى نتيجة كبرى، فإن المسرح، في تصوره، يقوم على جمع الشذرات الإنسانية الصغيرة لصناعة معنى كليّ نابض بالحياة. بهذا الفهم، لم يعد المسرح عند محمد مجرد نص يُمثّل، بل نظامًا معقّدًا من العلاقات، يخضع لمنطق التراكم، والتفاعل، والتكامل بين مختلف العناصر البصرية والصوتية والجسدية. وهكذا، لم تكن تجربة ثانوية أم أيمن مجرد نشاط مدرسي، بل كانت الورشة الأولى التي تبلورت فيها ملامح مشروعه المسرحي المختلف، مشروع سيظلّ يرافقه لاحقًا باعتباره جوهر رؤيته الفنية ومفتاح تميّزه.

فإذا كان التمسرح بحسب محمد خشلة “يعني تحويل حدث أو سلوك عادي إلى فعل له طابع مسرحي أو بمعنى آخر أن يكون فيه عرض، تمثيل، حضور، مخاطبة لعين المتفرّج، توجيه للجسد والفضاء… وحسب المفهوم النقدي والجمالي المستخدم في الدراسات المسرحية فالتمسرح يعني حضور البُعد الأدائي في أي فعل أو سلوك أو فضاء، بحيث يكتسب طابع العرض والتجسيد والتمثيل.“ فما هي العلاقة بين مفهوم ’التكامل’ في الرياضيات ومهوم التمسرح في الدراسات المسرحية؟، إنها ليست علاقة تقنية، بل مفهومية وفلسفية، وتظهر حين نفكّر في كيفية اشتغال كل مفهوم... فإذا كان “التكامل“ هو جمع عدد هائل من الأجزاء الصغيرة (مساحات، كميات، لحظات زمنية…) للوصول إلى كمية كلية … فالتمسرح هو تراكُم لحظات أداء صغيرة (حركة، نظرة، إيقاع، صوت، إيماءة، توقف…) هذه العناصر الدقيقة حين تُجمع تُنتج فعلًا مسرحيًا كاملاً... فإذا كان التكامل يدرس الظواهر غير الثابتة… فالتمسرح أيضًا … في التكامل نحن نتعامل مع ظواهر تتغيّر باستمرار سرعة تتغيّر، منحنى غير ثابت… في التمسرح العرض المسرحي هو حدث متحوّل لحظة بلحظة: الإيماءة تتغير، الصوت يتغير، التلقي يتغير، الفضاء يتغيّر… التكامل يلتقط الجوهر المستمر للظواهر المتغيّرة… والتمسرح يلتقط الأثر الأدائي المستمر للحظات التعبير المتغيّرة. كلاهما يعالج المتغيّر ويحوّله إلى معنى/كمية كلية... ولقد حاولت معالجة هذا المفهوم من خلال إصداراتي الخمسة قدر الإمكان”.
في سنة 1980، وتحت إشراف وإنتاج المناضل الراحل عبد العزيز الساقوط، عُرضت على خشبات فاس ملحمة “مولاي إدريس” من اخراجه، ذلك العمل الضخم الذي سيُعدّ واحدة من أبرز المحطات الفارقة في تاريخ المسرح الفاسي، شارك في هذه الملحمة معظم مسرحيي المدينة، فكانت أشبه بتظاهرة فنية جماعية، جسّدت روح المرحلة، واحتشدت فيها الطاقات الإبداعية من مختلف الاتجاهات والتيارات المسرحية. داخل هذا العمل الكبير، حاول محمد خشلة أن يختبر، لأول مرة على نطاق واسع، ذلك الهوس المفاهيمي الذي كان يتشكّل في ذهنه منذ سنوات، وإن ظلّ آنذاك غامض المعالم، غير واضح الحدود. لم تكن الأدوات الفكرية قد نضجت بعد لصياغته في قالب نظري متكامل، لكن الجرأة كانت حاضرة، والرغبة في كسر السائد أقوى من التردّد. ومن رحم هذه التجربة الجماعية، وُلدت واحدة من أهم الظواهر المسرحية التجريبية في فاس، فرقة الأصدقاء، التي ستُعرف لاحقًا باسم جمعية أصدقاء المسرح المغربي. لم تكن هذه الجمعية مجرد إطار تنظيمي جديد، وإنما إعلان تمرّد جمالي وفكري على القوالب المألوفة، أصدرت الفرقة بيانها الوحيد، الذي سُمّي لاحقًا بيان مسرح التكامل، محاولة من خلاله توضيح النهج الفني والفكري الذي اختاره هذا الجيل من الشباب. كان البيان أقرب إلى صرخة بحث عن مسرح جديد، يزاوج بين التجريد، والحركة، والمفهوم، والتكنولوجيا، في وقت كان فيه الجسم المسرحي المغربي منشغلًا بالصراع الإيديولوجي، وبالرهانات السياسية والاجتماعية المباشرة. تكوّنت جمعية أصدقاء المسرح المغربي، في مجمل أعضائها، من طلبة جامعيين جاؤوا أساسًا للمشاركة في ملحمة “مولاي إدريس”، لكنهم سرعان ما تحوّلوا إلى نواة صلبة لمشروع مسرحي مختلف، أنتج مجموعة من الأعمال التي عكست هذا التوجّه التجريبي الغريب عن المألوف. كانت أولى هذه التجارب مسرحية “قطرات”، تلتها أعمال مثل “فالس الأموات”، و”ثلاث في اليوم”، و”أبناء الرمل”، و”أسطورة السعادة”، ثم “هاملت والشيطان”، وكانت جميع هذه النصوص من كتابة المسرحي المتفرّد عبد الحميد دادس، الذي قدّم لغة مسرحية مختلفة، مشبعة بالتجريب والرمز والانزياح عن السرد التقليدي. كانت هذه الأعمال، في مجملها، صادمة للمتفرج العادي. فهي لا تُراهن على الحكاية بالمعنى الكلاسيكي، ولا على الصراع الدرامي الواضح، بقدر ما تراهن على الجسد، والإيقاع، والفضاء، والعلاقة الجديدة بين الممثل والمتلقّي. لقد حاولت هذه التجربة أن تستبق زمنها، أن تدخل مفاهيم رياضية وتجريدية وتكنولوجية إلى جسد المسرح، في وقت كان فيه المجتمع المغربي لا يزال بعيدًا عن هذه التحولات، غارقًا في صراعات إيديولوجية حادّة، ومشدودًا إلى معارك سياسية واجتماعية معقّدة، في ظل علاقة متوتّرة مع السلطة، ومحاولات متعثّرة للانعتاق الحضاري. غير أنّ وهج هذه التجربة لم يدم طويلًا، فمع تخرّج الطلبة الجامعيين الذين شكّلوا العمود الفقري لفرقة الأصدقاء، بدأ المشروع يفقد زخمه تدريجيًا، تفرّق الأعضاء في مسارات مهنية مختلفة، وانطفأت شعلة التجريب الجماعي بصمت. ولم يبقَ في الساحة سوى محمد، الوحيد الذي ظلّ وفيًا لهذا الهاجس النظري الغريب، رغم إدراكه العميق لصعوبة تمريره في واقع مسرحي وجمهور لم يكن مهيّأ بعد لاستقبال هذا النوع من الأسئلة المعقّدة. لقد كان مشروع “مسرح التكامل” في جوهره محاولة لتطبيق مفاهيم رياضية محضة على التجربة المسرحية، وهو أمر بدا، في تلك المرحلة، طوباويًا وغريبًا عن الوسط المسرحي المغربي، الذي كان ما يزال يرتكز على التعبير المباشر، والرسالة الواضحة، والرهان على التفاعل الشعبي البسيط. لذلك ظلّ محمد شبه معزول في هذا الاختيار، مؤمنًا بفكرته، لكنه واعٍ بصعوبتها وحدود انتشارها آنذاك. وبعد أفول تجربة الأصدقاء، عاد محمد إلى أحضان المسرح الشعبي، ذاك المسرح الذي يحبه الجمهور المغربي ويفهم لغته بسهولة. لم يكن هذا القرار تراجعًا بقدر ما كان تصالحًا مع الواقع، ومع إيقاع المتفرج اليومي. وهناك، سيشرع في إخراج أعمال لعدد من الأسماء البارزة في الكتابة المسرحية المغربية، من بينهم، محمد الجاي، ومحمد عزيز الجعفري، وعبد السلام مسير، وإدريس المعناوي، ولحسن القناني، ومحمد أصميد، ومحمد القروي، وأحمد الطيب لعلج، بعدها انتقل محمد من مغامرة تجريدية نخبوية، إلى مسرح شعبي نابض بالحياة، دون أن يتخلّى في العمق عن أسئلته الأولى. لقد ظلّ ذلك التوتر الخلاق بين التجريب والجمهور، بين الفكرة والمشهد، بين الحلم والواقع، هو الوقود الحقيقي لمساره المسرحي، ومحرك بحثه الدائم عن مسرح يُشبه الناس، دون أن يتخلّى عن جرأته في مساءلتهم.

مع مطلع تسعينيات القرن المنصرم، بدأ وهج مسرح الهواة في المغرب يتراجع تدريجيًا، كما تخبو نار كانت متّقدة بالأسئلة والجرأة والرهان على التغيير. لم يكن ذلك الخفوت وليد الصدفة، بل نتيجة مسار طويل من التضييق والتطويق، انتهى بما يشبه الإقبار الرمزي لهذه التجربة، حين تمكّن المخزن من كسب معركته الهادئة، وشرع في إعادة توجيه الحركة المسرحية نحو الوجهات التي يراها أكثر أمانًا وانضباطًا. وهكذا، انفتح فصل جديد في تاريخ المسرح المغربي سُمّي بـ “مرحلة مأسسة المسرح الاحترافي”، مرحلة ما تزال إلى اليوم تراوح مكانها، عالقة بين طموح التنظيم وحدود الحرية. في خضم هذا التحوّل العاصف، كان محمد حاضرًا في قلب النقاش، لا بصفته فنانًا فقط، وإنما باعتباره فاعلًا مدنيًا يؤمن بدور المسرح في الدفاع عن كرامة المبدع. مثّل، رفقة المرحوم محمد الكغاط، مدينة فاس في اللجنة التحضيرية لتأسيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، إلى جانب نخبة من المسرحيين المغاربة من مختلف المدن. كان ذلك الرهان محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من روح المسرح الحرّ، ولإعادة الاعتبار للفنان باعتباره فاعلًا لا مجرّد منفّذ. غير أن النار التي كانت تشتعل في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، لم تصمد طويلًا أمام رياح التسعينيات. انطفأ الوهج المسرحي في معظم ربوع المملكة، ولم يبقَ سوى ومضات متفرقة، فلتات قليلة عبر ثلاثة عقود، عاجزة عن إعادة إشعال ذلك الحريق الجميل الذي كان يومًا وقودًا للمدن، وفي مقدّمتها فاس. ولم تعد هذه المدينة، التي كانت ذات زمن منارة مسرحية وفكرية، تعرف ذلك الزخم الإبداعي الذي كان يملأ مسارحها وساحاتها وقاعاتها الجامعية. ضاقت فسح الأمل، وتحوّل الصمت تدريجيًا إلى طابع عام. بالنسبة لمحمد، لم يكن هذا التحوّل مجرّد أزمة فنية عابرة، بل كان جرحًا وجوديًا يتجدّد كل يوم. فقد تضاعف إحساس الخسارة حين تهاوت المنظومة التي شكّل داخلها حلمه، وحين رأى جيلاً كاملًا من المسرحيين يتفرّقون في منافي العمل والخذلان. لكن الضربة الأشدّ جاءت مع جائحة كورونا، حين اختطف الوباء زوجته، شريكة العمر، ورفيقة الدرب، وسنده الهادئ في محطات الانكسار والتعب. عندها، لم يعد الفقد فنيًا فقط، بل صار شخصيًا عميقًا، كأنما انهار الجدار الأخير الذي كان يستند إليه ليستمر.وجد محمد نفسه، في تلك اللحظة المفصلية، وحيدًا أمام زمن موحش، يبحث عن فسحة صغيرة يستطيع عبرها أن يتنفّس الفن من جديد، بعيدًا عن القيود، وعن الحسابات الضيقة، وعن الخيبات المتراكمة. كان كمن نجا من عاصفة طويلة، لكنه لا يزال يحمل في صدره غبارها. ومع ذلك، ظلّ في داخله جمر صغير لم ينطفئ تمامًا، جمر الإيمان بأن المسرح ليس مرحلة عابرة، بل قدرٌ طويل النفس، وأن البحث عن الحرية الفنية قد يضيق، لكنه لا يموت.
في سنة 2021، وبعد سنوات طويلة من الترحال بين الخشبات والخيبات الصغيرة والانتصارات المؤجلة، اتخذ محمد قراره الأشدّ جرأة في حياته، جمع حقائبه في صمت، واستقلّ سيارته متجهًا نحو الجنوب الشرقي من المملكة، إلى حيث يمتدّ الصمت أطول من الطرق، وحيث يسكن قصر أولاد الزهراء، قرية صغيرة منسية في إقليم أرفود، كأنها نقطة ضوء باهتة في خريطة الإهمال الطويل. كان ذلك المكان أكثر من مجرد وجهة جغرافية؛ كان هو الجذر البعيد الذي اقتُلِع منه أجداده ذات يوم، حين اضطروا في عشرينيات القرن المنصرم إلى الهجرة نحو فاس هربًا من الجفاف المعمّر، الذي التهم الزرع والضرع، وترك خلفه أرضًا عطشى وقلوبًا محمّلة بالرحيل، عاد محمد إلى تلك الواحة التي كانت يومًا نابضة بالحياة، فوجدها تتقلّص عامًا بعد عام؛ نخيلها يموت واقفًا، شبابها يفرّون إلى المجهول، وأطفالها يتفرّقون بين الضياع والخوف وقسوة الحاجة. هناك، وسط الرمل والعطش والتهميش، اتخذ محمد قرارًا آخر لا يقلّ جسارة، أن ينقذ ما استطاع من هؤلاء الأطفال، لا بالخطابات ولا بالشعارات، بل بالفعل المباشر. باع عقارًا كان يملكه في شمال المغرب، ذلك الذي كان يمكن أن يكون ملاذه الأخير، وحوّل ثمنه إلى حلم حيّ، فأسّس مركز الحاج محمد خشلة للتفتح الفني والثقافي بقصر أولاد الزهراء. لم يكن المركز مجرّد بناية، وإنما كان نافذة تُفتح في جدار العزلة، وجسرًا هشًّا بين قرية منسية وعالم واسع لا يعرف عنها شيئًا. مؤسسة ثقافية خُصّصت لرعاية الطفولة في منطقة تشكو النقص في كل شيء: الماء، الصحة، الثقافة، الأمل… ولا تفيض إلا بالعواصف الغبارية، بالعجاج، وبطبقات سميكة من الجهل وسوء الطالع. منطقة يقول أهلها، مازحين بمرارة، إن حتى الحيوان يأبى أن يستقرّ بها طويلًا. بدأ محمد العمل هناك من الصفر، دون امتيازات، دون دعم يُذكر، سوى إيمانه القديم بأن الفن يمكن أن يكون طوق نجاة، وبأن المسرح قادر على أن يوقظ الحلم حتى في أكثر الأراضي قسوة. فتح الأبواب للأطفال، علّمهم كيف يقفون، كيف يتنفسون فوق الخشبة، كيف يحوّلون الخوف إلى حركة، والخجل إلى صوت، والبكاء إلى تمثيل. شيئًا فشيئًا، بدأت الملامح تتغير: نظرات كانت مطفأة صارت تشعّ فضولًا، وأصوات كانت خافتة صارت تجرّب الصراخ والغناء والضحك. بعد أربع سنوات من العمل المتواصل، حدث ما لم يكن محمد ينتظره بقدر ما كان يتمناه في صمت، قرّرت السلطات التعليمية بجهة درعة تافيلالت أن تجعل من المجموعة المدرسية بالمنطقة نموذجًا للمدرسة الرائدة، بعدما تمكّنت من تخطّي معظم المتارس التي كانت تعيق انفتاح الأطفال على العالم، وتحقيق الريادة في عدد من مجالات التعلّم والمعرفة. كان ذلك اعترافًا رسميًا بأن المستحيل يمكن أن ينكسر، وأن الهامش حين يُمنح فرصة، قد يصير مركزًا صغيرًا للضوء.

أبدع أطفال قصر أولاد الزهراء في أكثر من مجال، لكن المسرح ظلّ هو المعجزة الأوضح. على خشبة بسيطة من ألواح متواضعة، صنع محمد معهم عروضًا مسرحية حيّة، نابضة بالبراءة والدهشة. صفق لها مسؤولو التربية والتعليم بالجهة قبل أن تصفق لها ساكنة القرية والإقليم. وكانت تلك اللحظات، حين يعلو التصفيق في فضاء اعتاد الصمت، أشبه بعيدٍ جماعيّ يتقاسمه الجميع: الأطفال، الأسر، والمعلم الذي راهن على الحلم، في عمق الجنوب الشرقي، أحسّ محمد أنه يولد من جديد، وأصبح لحياته معنى، نسي، ولو مؤقتًا، ذلك الإحساس الثقيل بالإحباط والتهميش والإقصاء الذي أبعده قسريًا عن مسقط رأسه، وتلاشى، بين ضحكات الأطفال وحركتهم فوق الخشبة، كل ذلك الإرهاق القديم المتراكم عبر العقود. عاد إليه ذلك الإحساس الأول بالزهو، بالافتخار، ذاك الشعور الذي كان يعرفه يومًا عند كل عرض مسرحي ناجح في فاس، لكنه صار الآن أعمق وأصدق، لأنه مرتبط بأطفال لم يكن يُنتظر منهم شيء، فصنعوا كل شيء. لم يعد محمد يبحث عن الأضواء، ولا عن الاعترافات الكبرى، ولا عن خشبات المدن الواسعة. كان يكفيه، في قصر أولاد الزهراء، أن يرى طفلًا يرتجف قبل الصعود إلى الركح، ثم ينفجر شجاعة أمام الجمهور. كان يكفيه أن تتحوّل الرمال إلى مسرح، وأن يصبح الهامش، ولو للحظات، قلب المشهد. هكذا، في أقصى الجنوب الشرقي، استعاد محمد معنى رسالته الأولى، أن الفن ليس ترفًا، بل خلاصًا. وأن من ينقذ طفلًا بحلم، كأنه أنقذ مستقبلًا بأكمله.

على صعيد السينما والتلفزيون، كان محمد خشلة حاضرًا بفعالية، حيث جمع بين التمثيل وصناعة الديكور، مبرزًا قدراته الفنية المتعددة التي امتدت خلف الكاميرا وأمامها. شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التي تركت بصمة في المشهد السينمائي المغربي، مظهراً تنوعه الفني بين الأداء التمثيلي الدقيق والإبداع في تصميم الديكور، بما يعكس رؤيته الجمالية وشغفه بالتفاصيل. ومن بين هذه الأعمال البارزة نذكر منها فيلم “الكابوس” لأحمد تاشفين، و” نهيق الروح” لنبيل لحلو، و” جوهرة النيل” لثيك لويس، و”صمت الليل” لإدريس شويكة، و”حدائق عدن” لألساندرو دلتري، و”ياقوت” لجمل بلمجدوب، و” هواجس منتصف الليل” لمحمد العليوي، و”يوسف” لرفييل ميرطيز، و”حب في موكادو” لسهيل بنبركة، و”جارات أبي موسى” لعبد الرحمن التازي، و”قلوب محترقة” لأحمد المعنوني، و” جلجامش” لبيتر رينكارد، وثلاث أشرطة قصيرة لايمان ضوايو، وأربعة أشرطة قصيرة لكل من يونس الركاب وهشام بلقاسم، و”خربوشة” لحميد الزوغي، و” صيف بلعمان” لشفيق السحيمي، و”العباسية” لخالد الإبراهيمي، و” موسم لمشاوشة” لعهد بنسودة، و”منسيي التاريخ” لحسن بنجلون، و”العربي” لإدريس المريني، و”الشعيبية بدوية الفنون” ليوسف بريطل، و”الفرسان” ( les chevaliers ) لجواكيم لفوس (Joachim lafosse )، و”ليلة غير عادية” لإدريس المريني.

لقد ترك محمد خشلة مساره المهني والفني بصمة عميقة في المشهد المسرحي المغربي، بدءًا من تقديمه للبرنامج الإذاعي “أضواء على المسرح” عبر الإذاعة الجهوية بفاس، حيث كان صوت المسرح يصل إلى أرجاء المدينة، ناشرًا الوعي والحميمية مع الجمهور. كما أسهم، كأستاذ سابق لتقنيات المسرح بالمعهد الملكي لتكوين الأطر التابع لوزارة الشبيبة والرياضة (الزيات)، في تكوين جيل من المبدعين المسرحيين، منقلًا لهم خبرته الواسعة وشغفه بالمسرح، وكان حاضراً على مستوى التنظيم النقابي والمجتمعي، حيث تقلد مناصب عدة منها، نائب رئيس الفرع الجهوي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بفاس، عضو المكتب الوطني للنقابة، ورئيس سابق للاتحاد المسرحي لعمالة فاس الجديد (دار أدبيبغ)، كما قاد الجمعية المسرحية الشعبية بفاس منذ عام 1984، مجسّدًا التزامه المستمر بتطوير المسرح المحلي والوطني. على صعيد الإنتاج والتنظيم الفني، أسس وأدار شركة مسرح التكامل للإنتاج الدرامي، ورأس مهرجان فاس الدولي لمسرح الطفل منذ دورة 2012 وحتى اليوم، كما كان وراء نجاح دورتي مهرجان المسرح التجريبي الأولى والثانية. ومن خلال عضويته في المكتب المركزي والنقابات الإقليمية والجهوية، لعب دورًا محوريًا في تعزيز الحركة المسرحية والمساهمة في صياغة سياسات الدعم والإبداع على المستوى الوطني، إضافة إلى ذلك، ترك بصمته الفكرية من خلال مؤلفاته المسرحية التي تُعد مراجع هامة في حقل المسرح المغربي، “مسرح التكامل” حيث لم يكن هاجس محمد خشلة الكتابة عن المسرح والمسرحيين حاضرًا في ذهنه يومًا، إذ كان انشغاله العملي بإنتاج العروض المسرحية يستأثر بكل تفكيره وجهده. كان يعيش داخل الفعل المسرحي لا على هامشه، يتنفس الخشبة، ويصوغ الرؤى عبر الحركة والضوء والصوت، دون أن يخطر بباله أن يوثّق هذه التجربة أو أن يضعها في إطار نظري مكتوب، غير أن مسار الأشياء لا يسير دائمًا وفق ما نخطط له. حين تأسست فرقة أصدقاء المسرح المغربي، وسط سياق فكري وإيديولوجي محتدم، ومع بروز المسرحي عبد الكريم برشيد، رائد الاحتفالية، متربعًا على عرش التنظير المسرحي بالمغرب، وجدت محمد خشلة نفسه أمام ضرورة فكرية وأخلاقية للتعريف بهذه التجربة الجماعية التي خاضها رفقة ثلة من الشباب المتحمس للمسرح والتجريب. كانت تجربة نابضة بالأسئلة والقلق والبحث عن لغة مسرحية مغايرة، أفرزت مجموعة من العروض المتفردة في رؤيتها وبنائها، وانتهت بإصدار بيان مسرحي عنونه بـ “مسرح التكامل”، بوصفه مقترحًا فكريًا وجماليًا يتجاوز التجزئة إلى وحدة الرؤية والاشتغال. ومع إحالة سنوات طويلة من العطاء التربوي إلى التقاعد، اتسع الزمن من حوله، ولم يعد العذر الزمني قائمًا، عندها فقط أدرك أن الوقت قد حان لكتابة هذا الكتاب، لا بوصفه مجرد توثيق لتجربة مسرحية، ولكن باعتباره مساءلة فكرية لعلاقة غريبة وممكنة في الآن ذاته، علاقة حساب التكامل بطريقة تفكيره وهو يزاول عملية الإخراج المسرحي، كيف يتقاطع الرياضي بالجمالي؟ كيف تتحول المعادلات إلى إيقاع، والبنية الرياضية إلى رؤية إخراجية؟ أسئلة حاول أن يفتح لها أفقًا في هذا الكتاب، ليكون شهادة على مسار، ومحاولة لفهم ذاته عبر المسرح، وفي الكتاب الثاني “الدرس المسرحي عند مسرح الهواة”، وسعى محمد خشلة في هذا الكتاب إلى تعميق وتوضيح ما ورد في كتابه الأول “مسرح التكامل”، الذي دوّن فيه، ما كان يتدفق إلى ذهنه من أفكار ورؤى، محاولًا رسم ملامح بيبليوغرافية لمساره الفني وتوثيق تجربته في الحقل المسرحي، غير أن هذا العمل الجديد لا ينهج المسلك الأكاديمي الصارم الذي ينشغل عادة بتحليل النص الدرامي وتصنيفه ضمن الأجناس الأدبية، بقدر ما ينحاز إلى التأمل في التجربة من داخلها، ومن زاوية الممارسة الحية. فرغم أنه أطلق على مشروعه اسم “مسرح التكامل”، فإنه لا يزعم التنظير بقدر ما يتوقف عند تجربة مسرحية طويلة، صنع عبرها عروضًا بطابع خاص، دفعته إلى هذه التسمية. وفي هذا الكتاب يعود إلى هذه التجربة بقراءة أوسع وأعمق، باعتبارها واحدة من بين التجارب الغنية التي شكّلت ملامح مسرح الهواة بالمغرب. ينفتح الكتاب على الجانب المعرفي لرجل المسرح الهاوي منذ بداياته، ويطرح سؤالًا مركزيًا، هل الهواة مسرحيون؟ كما يتتبع مسار تشكّل وعيهم الدرامي عبر التعلم الذاتي، والورشات، والممارسة، في حقبة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وأسهمت في صنع ما يُعرف بـ “الزمن الجميل” للمسرح المغربي. وهو زمن عاشه عن قرب داخل جمعيات مسرحية بمدينة فاس، المدينة التي شكّلت رافدًا علميًا وثقافيًا لعدد كبير من المسرحيين والمفكرين. ينقسم الكتاب إلى جزأين متكاملين: جزء فكري يستخلص خلاصات القراءة والنقاشات التي شهدتها مهرجانات الهواة، ويستحضر أثر التكوين على يد الفنان الراحل أحمد زكي العلوي. وجزء تطبيقي يضم التمارين والورشات التي شكّلت المعمل الحقيقي لتكوين الهواة في فاس وبمختلف مناطق الوطن. كما يتناول الكتاب تحليل العرض المسرحي لا بوصفه نصًا مكتوبًا فقط، بوإنما باعتباره فعلًا حيًا، إخراجًا، وتمثيلًا، وحضورًا، وإيقاعًا، وأضواء، وأجسادًا، وعلاقة سرية بين الممثل والجمهور، في محاولة لفهم جوهر المسرح كما يُلعب ويُعاش، في الكتاب الثالث.“ثلاث مرتجلات”، ويتناول فيه على امتداد مسيرته المسرحية، حيث خاض تجارب متعددة بدافع الشغف والتساؤل أكثر مما كان يحركنه هاجس التأثير أو صدى التجربة داخل الوسط المسرحي الفاسي. كانت الأفكار تتدفق، فيجربها دون كثير اكتراث بالنتائج الآنية، إلى أن تراكبت هذه التجارب وتكاثفت لتشكل فيما بعد ما اصطلح على تسميته بـتجربة “مسرح التكامل”، ولم يكن لهذا التراكم أن يتحقق لولا ذلك الجيل من الشباب المتحمس الذي شكّل نواة جمعية أصدقاء المسرح المغربي خلال عقد الثمانينيات، بما حمله من روح التمرد على السائد، وتوق صادق إلى التجديد والاختلاف، لقد كانت تلك المرحلة زمنًا خصبًا، يمكن اعتبار كل عرض مسرحي فيه تجربة قائمة بذاتها شكلًا ومضمونًا، وعلى مستوى كل تقنيات العمل المسرحي. بعد تجربة جمعية الأصدقاء، وجد محمد خشلة نفسه منخرطًا في مغامرة جديدة مع جمعية المسرح الشعبي لإنقاذها من الاندثار بعد رحيل أغلب أعضائها المؤسسين. وكانت هذه الفرقة تمثل ركيزة أساسية في تاريخ المسرح الفاسي. مع من تبقى من أعضائها، حاول الحفاظ على نهجها القائم على الارتجال وصنعة التمثيل، حيث كانت العروض تُفصَّل على مقاس الجمهور الحاضر، بل إن إعادة بناء التوزيع والحبكة كانت تتم أحيانًا ساعة العرض. وهي مهارة نادرة لم يكن يتقنها سوى أعضاء المسرح الشعبي، بوصفهم “اصنايعية” حقيقيين في حرفة التمثيل، كما يتقن الصناع التقليديون حرفهم. وفي ظل التراجع الملحوظ للاهتمام بالفن والمسرح داخل المجتمع المغربي، وتدني الذوق الفني وانتشار الرداءة، وجد نفسه في مواجهة دائمة مع هذا الانحدار، من خلال العمل مع مجموعات من الشباب يفتقرون إلى أبجديات التقنيات المسرحية. عندها عاد إلى الارتجال بوصفه مدخلًا تربويًا وجماليًا لتأهيل الممثل الهاوي، وكشف أسرار الممارسة المسرحية التي لا تُدرك إلا بالزمن والتجربة. وقد كان الراحل محمد الكغاط من أوائل من راهنوا على المرتجلة لمناهضة الفوضى الفنية والمؤسساتية، مؤمنًا بأنها سبيل لنهضة مسرحية بهوية مغربية أصيلة. غير أن الواقع اليومي جعله يلجأ إلى المرتجلة لا لمقاومة الفوضى فقط، بل لتكوين الممثل من جديد. فجاءت “مرتجلة 11 شتنبر” لترسيخ البعد التاريخي والأخلاقي لمسؤولية الفنان، و”مرتجلة كورونا ” لاختبار قدرة الممثل على توظيف ثقافته الذاتية، و”مرتجلة عطيل” لتنقية العلاقة بين الممثل والجمهور من الصور الدونية المجحفة. وهي قيم كانت تُكتسب تلقائيًا داخل الجمعيات المسرحية، لكنها اليوم مفقودة، وبدونها لا يمكن للمسرح المغربي أن يستعيد عافيته، ثم الكتاب الرابع،”الزهرانيات”، ويؤكد فيه على أن المغرب، خلال الفترة الممتدة من مطلع ستينيات القرن الماضي إلى حدود الثمانينيات، عرف طفرة إبداعية لافتة قادها الهواة بشغف نادر، وأسهمت في إشعاع فني وثقافي مميز. غير أن هذه الدينامية ما لبثت أن بدأت في التراجع التدريجي، إلى أن خبت جذوتها مع نهاية القرن، في مفارقة مؤلمة تناقض المسار الطبيعي لتطور الأمم. فبدل أن يحيا الفنان المغربي في كنف الكرامة والاعتراف، كما يليق بدوره الحضاري، وجد نفسه منذ نهاية التسعينيات إلى اليوم محاصرًا بالتهميش وضيق سبل العيش. في خضم هذه الأجواء القاسية، تشكل وعيه الفني بين عشق التمثيل والفنون التشكيلية، وأنتج أعمالًا جسدت مخاض مرحلة متقلبة. وكان هذا الشغف الجامح، شأنه شأن كثير من الرواد، دافعه الأساس تحدي العوائق الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في رفع اسم المغرب في سماء الإبداع. غير أن وباء كورونا، حين اختطفت منه رفيقة العمر، كسرت شيئًا عميقًا بداخله؛ خبا الحماس، وضاقت به فاس، المدينة التي احتضنت نبضه الفني. توقفت الحياة في نظره، وتوقفت معها الرغبة في الإنتاج، حتى بدأ اليأس يفتح أبوابه على مصراعيه. عندئذ استعاد مقولة قديمة “بلاد الذل تُهجر” وبعد أكثر من خمسة عقود من العطاء، شعر محمد بأن المشهد أظلم، وأن الرداءة بسطت سلطانها، فحمل ألمه وغادر مدينته نحو أقصى الجنوب الشرقي، موطن الأجداد، حيث الفقر والجفاف والتهميش، وحيث المعرفة والثقافة والفن لا تصل إلا عرضًا، ويعيش الأطفال أقسى صور الحرمان. هناك، في قصر أولاد الزهراء، وُلد الأمل من جديد. حمل رغبته في أن يزرع الضوء في عيون الأطفال، وأسست مركز الحاج محمد خشلة للتربية والتفتح الثقافي والفني، في مبادرة بدت للبعض مغامرة مستحيلة، وبشراكة مع مدير شاب يقاوم الجهل والتهميش، انطلقت تجربة تربوية فريدة، تُوّجت بعد أربع سنوات باعتراف رسمي بالمؤسسة كـ “مدرسة رائدة” بجهة درعة تافيلالت. أبدع أطفال قصر أولد الزهراء في مجالات عدة، وكان المسرح أبرزها. قدم عروضًا صفق لها المسؤولون والجمهور على السواء، فأعاد ذلك إليه نبض الحياة، ومسح عن روحه غبار الإحباط. ويضم هذا الكتاب خلاصة هذه التجربة، من نصوص مسرحية اشتغل عليها مع هؤلاء الأطفال، لتكون بذور أمل، ومصدر إلهام لرواد إبداع آخرين في دروب العتمة. وفي الكتاب الخامس “المكينة المسرحية” أو الثورة المسرحية الرابعة، على امتداد أكثر من أربعة عقود من الاشتغال المسرحي، ظل يراود محمد خشلة إحساس دائم بأنه أيغرِّد خارج السرب؛ يفكر بطريقة مغايرة لما هو سائد، وأُنجز عروضًا قد لا تستجيب دائمًا لأفق انتظار الجمهور العريض. كثيرًا ما كان يراجع اندفاعه، ويعدّل من نزوعه الحالم، ويعود إلى ما يضمن الإقبال والقبول، غير أن صوتًا داخليًا كان يعود في كل مرة ليستفزه، ويدفعنه إلى سلوك المسالك الوعرة التي لا تستوعبها الأغلبية، إيمانًا منه بأن المسرح لا ينبغي أن يظل سجين المقاربات الاجتماعية وحدها، بل فضاءً مفتوحًا على كل المعارف. كان يجد سعادته الحقيقية حين أيقحم في أعماله المسرحية علومًا أخرى، من الرياضيات والفيزياء المرتبطتين بالتكنولوجيا الحديثة، إلى العوالم الباطنية والروحية، إلى الاكتشافات العلمية المتجددة. غير أن هذا التوجه كان يضعنه في مواقف حرجة، بسبب قلّة من يُصغي إلى هذا المشروع الذي كان يمارسه عن قناعة وشغف عميقين، وكثيرًا ما قوبل بالريبة أو بعدم الفهم. لكن التقاعد شكّل منعطفًا حاسمًا في مساره؛ إذ أتاح له زمنًا واسعًا للقراءة والبحث والتأمل. عندها أدرك أنه ليس استثناءً في هذا العالم، بل هناك مسرحيين كثيرين، عبر مختلف الثقافات، يشتركون في الطموح ذاته، مسرح يساير التحولات التكنولوجية الكبرى، ويخاطب جمهورًا متعطشًا للتجديد. ومع ثلة من الشغوفين بالجديد، كان يدخل باستمرار تعديلات على الفرجة المسرحية، كي يظل المسرح مرآة حقيقية للمجتمع، عاكسًا لتحولاته الفكرية والمادية. وانطلاقًا من هذا الوعي، يأتي هذا الكتاب بوصفه رحلة فكرية وجمالية عبر الزمن والمفاهيم. أستهلها من جذور “المكينة المسرحية”، متتبعًا حضور الآلة منذ العصور القديمة إلى زمننا المعاصر، بوصفها شريكًا خفيًا في بناء العرض. ثم يقف عند التحولات الجذرية التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية في الإخراج، والكتابة الركحية، وأداء الممثل، وصولًا إلى الفن الرقمي بوصفه أفقًا تعبيريًا جديدًا فوق الخشبة. كما أفرد حيزًا للذكاء الاصطناعي، هذا الفاعل المستجد الذي لم يعد يكتفي بمرافقة العملية المسرحية، بل صار يتدخل في بنائها نصًا، وإخراجًا، وتواصلاً مع الجمهور. وفي ختام هذا المسار، يتوقف محمد خشلة عند واقع المسرح العربي، متأملًا تحدياته في استيعاب هذه التحولات، وباحثًا عن الجسور الممكنة بين الخصوصية المحلية والطموح الكوني. إنه كتاب موجّه لكل من يرفض أن يُحبَس المسرح في قوالب جامدة، ولكل من يؤمن بأن الإصغاء إلى روح العصر لا يعني أبدًا التفريط في روح المسرح.

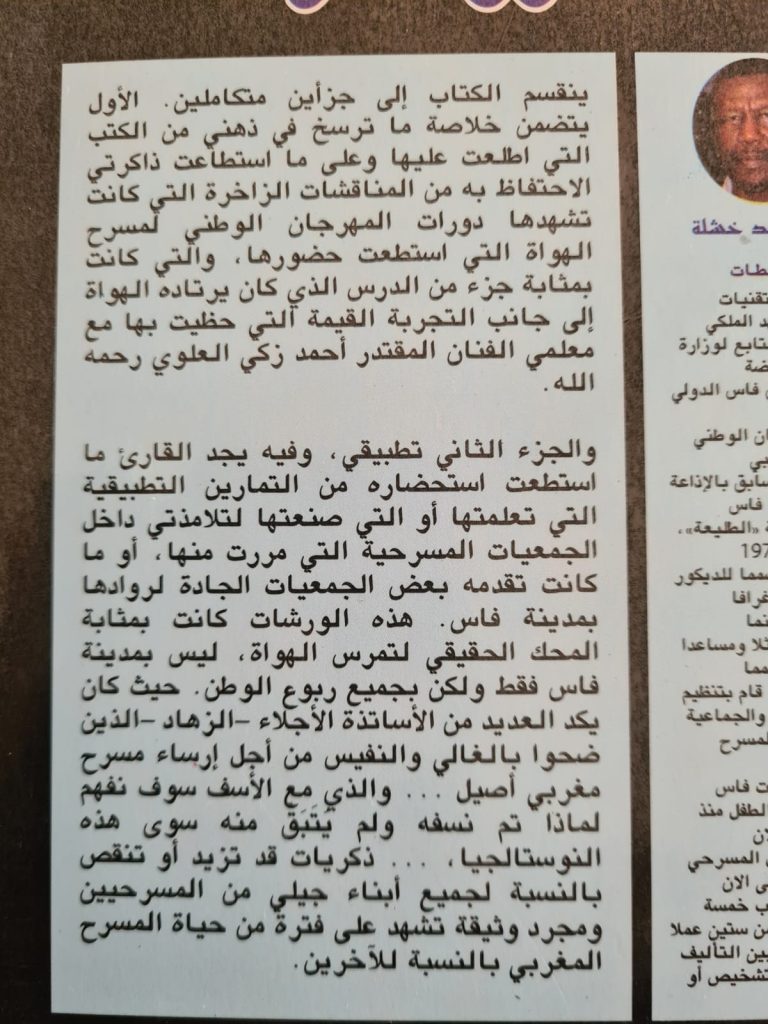

يمكن القول إن مسيرة محمد خشلة تمثل نموذجًا حافلًا بالتجربة التعليمية، والإبداع الفني، والنضال النقابي، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة المسرح المغربي كرمز للعمل المتواصل من أجل الفن والثقافة. يمثل محمد خشلة أحد أبرز المفكرين المسرحيين والمناضلين الحقيقيين، ليس فقط على مستوى مدينة فاس، بل على امتداد المشهد المسرحي المغربي ككل، طوال مسيرته الفنية الطويلة، بذل كل جهده، مستغلاً شتى الوسائل المتاحة، ليظل الصوت المسرحي الحر حاضرًا، ولتظل قضايا المسرح، والفن، والطفولة، والحريات الثقافية حيّة في وعي المجتمع، لم يكن نشاطه مجرد ممارسة فنية، بل كان مشروعًا فكريًا متكاملاً، يحاول من خلاله إعادة تعريف المسرح في المغرب، عبر الجمع بين الفكر الفني والابتكار، وبين الانخراط الاجتماعي والتربوي. ورغم هذا الالتزام العميق، لم يحظَ محمد بالخروج إلى الضوء الذي يستحقه، ولم يُقدّر جهده في الكثير من المحطات، لم تنصفه الأطر الرسمية، ولم يلقَ صوته الاهتمام الذي يتوافق مع قيمة إبداعه الفكري والميداني. كثيرًا ما وجد نفسه يقاوم وحده في صمت، يحاول بناء أفكاره ومشروعه المسرحي دون سند، في مواجهة الوسط الذي لم يكن دائمًا متقبلاً للتجريب، أو مستعدًا لاستيعاب النهج الجديد الذي اختاره. كانت محاولاته لإبلاغ صوته وطرح رؤيته أشبه بمحاولة لإشعال نار صغيرة في فضاء واسع ومعتم، غير أن إيمانه بالفكرة وبقدرتها على التغيير ظل هو القوة الدافعة له.

لقد كانت مقاومته وحيدًا، وبذله المستمر للجهد في سبيل المسرح والفكر، شهادة على شغفه العميق وحبه للفن، وليس مجرد بحث عن الاعتراف أو الشهرة. وبهذا المعنى، يظل محمد خشلة مثالًا للفنان المفكر، الذي يفهم أن التغيير الثقافي لا يحدث بسهولة، وأن الطريق نحو الاعتراف بالقيمة الحقيقية للفن والفكر طويل وشاق، لكنه يظل مستمرًا في السعي، صامدًا رغم الإقصاء، ومواصلًا لمسيرته بإيمان راسخ بأن صوته، مهما تأخر سماعه، جزء من النسيج الحي للحركة المسرحية المغربية.

